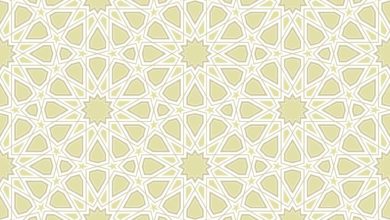للمظلوم أن يحتج بجميع الوسائل

للمظلوم أن يحتج بجميع الوسائل
التجديد نشر في التجديد يوم 28 – 01 – 2011
أجرى موقع ” أون
إسلام نت” حوارا مع الخبير أحمد الريسوني بمناسبة الأحداث التي عرفتها يعض
الدول العربية واستفسرته حول رأيه الفقهي من الإحتجاج. وفيما يلي نص الحوار:
توجهنا للدكتور الريسوني
بتساؤلات حول فقه الاحتجاج؛ سعيا لتفهم ضوابط الشرع لحالة الغضب التي عمت بعض
مناطق عالمنا العربي، وأفاد د. الريسوني في هذا الإطار بأن للمظلوم أن يحتج بكل
وسيلة إلا الظلم والإفساد في الأرض، وأن المظلوم وجد استثناءا في الشرع يبيح له
التجاوز لإبلاغ مظلوميته، شريطة عدم اقتراف إثم. وقد صاغ د. الريسوني رأيه
بالاستناد للقاعدة الفقهية التي مفادها أن الاحتجاج نوع من إنكار المنكر الواجب
المشروط بعدم إتيان منكر أكبر. وقد نبه الريسوني إلى أن الاحتجاج الذي حرمه الشرع
هو الاحتجاج عبر استعمال السلاح. وأكد أن هذا الاحتجاج المسلح مرفوض عند أهل
السنة، منبها إلى أن حمل السلاح إنما هو لجهاد الأعداء فقط، وأن الحالة الوحيدة
التي أبيح فيها استعمال السلاح بين أطراف الأمة؛ إنما كان لوقف استعمال السلاح.
وقد علل الريسوني هذا الحكم بأن حمل السلاح يؤدي لقتل الأبرياء، بينما يظل
المفسدون مختبئين لا يطالهم السوء. وأكد أنه لا يجوز للأجهزة الأمنية والعسكرية
شرعا أن تستعمل السلاح وتقتل به إلا لإخماد تمرد مسلح. وأكد أن الذين يأمرون بقتل
المدنيين والذين ينفذون هذا الأمر هم مجرمون وقتلة شرعا؛ يقعون تحت طائلة تشريع
القاتل العمد.
س: فضيلة الدكتور أحمد
الريسوني.. بالنظر إلى أحداث تونس، وموقف علمائنا وفقهاءنا من تقدير بعض الملابسات الخاصة
بها، منها مثلاً انتحار البوعزيزي، وتكييف المسألة بصورة جاوزت السائد في رؤية
الفقه من الحكم بكفره كفرًا لا يخرج من الملة، ولكنهم دعوا الناس للدعاء له
ولالتماس الرحمة له وهكذا. فهل هذا يعني أن ثمة خصوصية ما لفقه الاحتجاج تجعل ثمة
أحكاما تخصه وحده دون غيره، بالنظر للظرف الذي تعاني منه معظم بلادنا العربية
والإسلامية؟
د. أحمد الريسوني: بسم
الله الرحمن الرحيم. أولاً لا أعلم أن هناك من يكفر المنتحر، المنتحر هو مسلم، إذا
عاش فقد عاش مسلمًا، وإن مات فقد مات مسلمًا. فهو مسلم. الانتحار ليس بكفر بحالٍ
من الأحوال. لكن الانتحار مُحرم أشد التحريم، وهذا لا شك فيه. لكن الحالة التي نحن
بصددها، بدون شك، حالة لها خصوصية، فأن يصل الإنسان إلى حد أن يفقد فيها كامل وعيه
واتزانه وتعقله؛ فمن هذا الباب تأتي خصوصية النظر للقضية. فكل إنسان يقدم على عمل،
وقد ارتفع عقله وانعدمت إرادته، أو انخرمت إرادته، فبدون شك هذا له حكم خاص، فهناك
أحكام تتعلق بالمكره والمضطر والملجأ، كل هذه أمور لها اعتبارها في الفقه الإسلامي.
ففي الفقه الإسلامي نجد
أحكاما تطال حتى الإغلاق في الغضب. لذلك كثير من الفقهاء يرون أن لا طلاق في
إغلاق. فإذن هذه أحكام لها خصوصياتها. فالإنسان الذي يقدم على الانتحار وهو في
تمام وعيه وإرادته، هذا حكمه هو الحكم المعروف، فقد ارتكب إثمًا مبينًا، واقترف
كبيرة من الكبائر، لكن حينما يصل إنسان تحيط به ظروف وملابسات يختلف فيها عقله
وإرادته فهذا شيء آخر.
فلذلك نحن نرجو لهذا
الشاب، ولكل من يقدم على مثل هذا الفعل، أن يشمله عفو الله، وأن يكون في حالة
يرتفع فيها عنه الإثم والملام، ويشمله فيها العفو، هذا وارد في ديننا بهذا
الاعتبار.
أما قضية دائرة الاحتجاج،
ودائرة ما يجوز فيها وما لا يجوز، فالشرع أجاز الاحتجاج؛ سواء كان سياسيًا أو غير
سياسي. فكل إنسان يحتج حتى على أفراد من أصدقائه، أو شركائه إلى آخره، وبخاصة إذا
كان احتجاج مظلوم؛ فله أن يحتج بجميع الوسائل، ما عدا أن يحتج أيضًا بظلم غيره، أي
ما لم يظلم غيره، وما لم يكن عمله إفسادًا في الأرض، وما لم يلجأ إلى القتل وما
إلى ذلك من أشكال العدوان والبغي، فله أن يحتج بكل شيء إلا بالإثم. والله تبارك
وتعالى يقول: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم). فهذا أصل يبين أن
هناك أمور لا تجوز بعامة، لكنها تجوز إذا كان الإنسان مظلومًا. فالجهر بالسوء من
القول لا يجوز، والله تعالى يقول: (وقولوا للناس حسنًا). فالجهر بالسوء من القول
هو قول سوء أي فيه خشونة، وفيه تجريح وبغى، ثم هو يجهر به ويقوله أمام الملأ وبصوت
مرتفع، هذا لا يجوز إلا من تعرض للظلم.
ومعنى الآية ومفهوم الآية
أن من ظلم جاز له أن يفعل ما لا يجوز لغير المظلوم فعله، وجاز له أن يقول وأن يرفع
صوته وأن يعبر التعبير القوي الذي يبلغ ويوصل مظلوميته. فله أن يرفع من سقفه
احتجاجه، ومن سقف مقاومته للظلم.
فإذن ليس هناك حد لهذا
الاحتجاج، بل هو الاحتجاج على الظلم، والاحتجاج بدون شك هو نوع من إنكار المنكر،
ونوع من تغيير المنكر، وتغيير المنكر كما يقول العلماء من ضوابطه عند العلماء ألا
يأتي بمنكر أكبر، بمنكر أكبر يعني متوقع، يعني الإنسان قد يصل إلى نتائج غير
متوقعة، هذا لا يلام عليه أحد.
الإنسان قد يسافر للتجارة
فيلقى حتفه، هذا لم يكن متوقعًا، لا يلام عليه، لكن إن كان متوقعًا يلام عليه، لا
يرام الإنسان للتجارة بروحه إذا كان المغامرة واضحة، والخطر واضح.
فإذا الإنسان، كل إنسان
فردًا أو جماعة إذا أقدم على ما فيه إنكار المنكر، وما فيه تغيير المنكر، وهو يرى
أن هذا التغيير حتى لو كان فيه بعض الأضرار، وبعض الخسائر، هو يؤدي إلى إزالة هذا
المنكر، ولا يأتي بمنكر أكبر منه، فإن هذا الاحتجاج يجوز.
وعلى العموم بالنسبة
للتغيير المنكر، خاصة الجماعي والاحتجاج الجماعي والمعارضة الجماعية السياسية حتى
نقترب من موضوعنا أكثر، الذي حرمه الشرع هو استعمال السلاح، وما سوى ذلك من أشكال
الاحتجاج والتغيير، إذا استوجبت الحالة فذلك جائز، بل قد يكون واجبًا.
س: فضيلة الدكتور.. تاريخ
الاحتجاج وأدبياته يشير إلى مدارس ثلاث، مدرسة الخروج، وهذه برزت في النتاج الفقهي
والفكري للخوارج، مدرسة التمكن وهي برزت عند المعتزلة بشكل خاص ومن أهل السنة من
نحى هذا النحو وبخاصة الأحناف، وتم تصنيف بقية أهل السنة والجماعة في مدرسة الصبر.
ما تطرحه يعتبر جديد على هذه المساحة التي اتسمت تاريخيا بملازمة الصبر فيما يتعلق
بعلاقة الحاكم بالمحكوم، فما القائم وراء هذا التطور؟
د. أحمد الريسوني: هنا نحن
بصدد اتجاهين في الحقيقة وليس ثلاثة، حتى نسمى الأمور بأسمائها. هناك من يرون
خروج: أي حمل السلاح، لأن الخروج في الفقه وفي المصطلح الإسلامي يعني الخروج
المسلح، وهناك من لا يرون هذا في أي حال من الأحوال إلا في حالة كفر الحاكم.
وهذا كله مستنده الأحاديث.
فجمهور علماء السنة، لديه ما يشبه الإجماع؛ وبخاصة عند المتأخرين على منع الخروج.
والدعوة إلى الصبر معناه منع الخروج المسلح. ولا أحد يقول بالصبر الذي يعني الصمت.
ولا أحد يقول بالصبر الذي يعني إقرار منكر قائم أو فساد قائم. هذا ليس من قول أهل
السنة، وليس من السنة في شيء.
فأهل السنة يقولون بما
قالت به السنة، وهو النهي عن حمل السلاح والخروج المسلح، ويرفضون استعمال السلاح
في الجسم الإسلامي وفي الداخل الإسلامي. هذا لا يجوز لأن السلاح إنما هو لجهاد
الأعداء، والدفاع عن الأوطان وعن الذات في مواجهة المخاطر الخارجية.
الحالة الوحيدة التي أبيح
فيها استعمال السلاح داخليًا هي استعمال السلاح لوقف استعمال السلاح. بمعنى.. إذا
وجدت طائفة باغية ولم تستجب لداعي إلقاء السلاح، ولم توقف بغيها المسلح، حينئذ يجب
على المسلمين أن يقاتلوها حتى تفئ إلى أمر الله فقط، فإن فاءت فأصلحوا. أما معارضة
الحكام والدول القائمة والأمراء والحكومات بالسلاح هذا لا يجوز، كما في الأحاديث
المعروفة إلا أن تروا كفر بواحًا. هذه الأحاديث هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا هديه.
فإذن جمهور أهل السنة
متلزمون بهذا ويقولون: حتى إن وقع ظلم وعسف واستبداد لا نجيز حمل السلاح، ولا نجيز
استعمال السلاح في الصف الإسلامي، ووضحوا حكمة ذلك وسببه؛ وهو أن استعمال السلاح
أولاً يؤدي إلى فتنة عارمة، ثانيًا يؤدي حتما إلى إزهاق الأرواح البريئة، لأنه
حينما يبدأ استعمال السلاح أول ما يقتل هم الأبرياء من الطرفين.
يعني: إذا وقع احتجاج في
أي بلد؛ يقتتل المواطنون ورجال الشرطة كما حدث بتونس، أو يقتتل المواطنون والجنود كما حدث مثلاً في الحالة الجزائرية، قضيت سنون من الاقتتال بين هؤلاء الشباب الذين حملوا
السلاح وبين إخوانهم وأقربائهم من رجال الشرطة ورجال الجيش والدرك، بينما
المستهدفون بهذا القتال (الظالمون المقترفون للمنكر) في بيوتهم وأماكنهم، آمنون
مستقرون، لم يصلهم السلاح ولم يمسهم. فما يحدث في الاحتجاج المسلح فتنة وغوغائية
وقتل عشوائي. هذه المفاسد كلها أغلق بابها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع
الاحتجاج بالسلاح، وحظر المقاومة بالسلاح للحاكم الظالم وللدولة الظالمة. لكن قلت
وأؤكد: ما سوى ذلك كله مباح عند أهل السنة والجماعة.
س: هذا يشمل كافة أشكال
الاحتجاج السلمي غير العنيف؟
د. أحمد الريسوني: نعم،
لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله. ففي الاحتجاج يعبر الناس عن مظالمهم، ويعتصمون
بالمساجد، ويفعلون ما بدا لهم، هذه أمور مفتوحة؛ لأن الله تعالى قال: (قل تعالوا
اتلوا ما حرم ربكم عليكم) فما لم يتلوه ربنا علينا، وما لم يسمه حرامًا، فهو مباح.
إذن، الله تعالى؛ سواء في
الاحتجاجات أو غيرها، سياسية أو غيرها، الله يحرم العدوان، ويحرم القتل، ويحرم
الفساد، أي الإحراق والهدم وما إلى ذلك، هذا حرام بدون شك، أيًّا كانت الأسباب.
لكن مجرد الاحتجاج والضغط على الظالم ليكف ظلمه، وعلى المفسد ليكف فساده، وليرتفع
هذا الفساد وهذا الظلم وهذا التسلط، هذا بدون شك جائز، بل هو شيء شرعي ومطلوب، وهو
من باب تغيير المنكر، ومن باب إنكار المنكر.
س: بالرجوع إلى التجربة التونسية؛ فضيلة الدكتور، وجدنا نموذج الجنرال رشيد عمار في مقابل
نموذج الجنرال الحاكم المخلوع زين العابدين بن علي، فهذا الأخير دفع جنوده
لاستخدام السلاح، بينما الأول أمسك؛ وأمر جنوده بعدم رفع السلاح في وجه المواطنين التونسيين، ففي هذه الحالة كيف نكيف سلوك الحاكم الذي أمر بحمل
السلاح، بالنظر لانتمائه لجهاز الدولة؟
د. أحمد الريسوني: كما قلت
من قبل، المحتجون أو المتظاهرون أو المنكرون للمنكر لا يجوز لهم حمل السلاح
واستعمال سلاح. وكذلك الدولة والحاكم، لا يجوز له استعمال السلاح ضد المسلمين، إلا
أن يكونوا هم أيضا حملة سلاح كما قلت، فيكون استعمال السلاح لإيقاف استعمال السلاح
فقط؛ لأن الطائفة الباغية عندنا في الشرع هي التي حملت السلاح، هذا هو البغي
الوارد في سورة الحجرات (فإن بغت إحداهما على الأخرى) هذه الآية هي الشاهد
المقصود، والبغي هنا هو الاقتتال كما في سياق الآية.
فكما لا يجوز للفئة
الباغية أن تحمل السلاح ضد الدولة أو ضد طائفة أخرى من المجتمع، فكذلك لا يجوز
للدولة وللشرطة وللجيش، للجندي وللشرطي، لا يجوز لأولئك أن يستعملوا السلاح؛
فيقتلوا به إلا إذا كانوا يخمدون تمردًا مسلحًا. فالقاعدة أن: “السلاح للسلاح”،
الدولة تستعمل السلاح ضد السلاح. أما استعمال سلاح ضد المدنيين والمتظاهرين
والهاتفين والمطالبين، هذا لا يجوز، وإن حدث فيه قتل فهو قتل عمد؛ يجب فيه ما يجب
شرعًا، سواء أكان من شرطي أو من جندي أو من ضابط أو من جنرال.
الذين يأمرون بقتل
المدنيين هم مجرمون بدون شك. هم قتلة. والذين ينفذون هم مجرمون وقتلة. إذن ما دام
هناك خروج سلمي وتظاهر سلمي فيجب أن يترك، ويمكن أن تكون له إجراءات تنظيمية، كما
في الدول الراقية والمتحضرة. لكن أن يواجه المتظاهرون؛ وهم مدنيون عزل؛ بالسلاح
فهذا قتل كأي قتل آخر، ويحاسب عليه أصحابه إن لم يكن في الدنيا وفي الآخرة.
س: فضيلة الدكتور.. بعض
محاولات التجديد الفقهي حملت في دعوتها التجديدية ما يشبه الاتهام لجانب عظيم من
التراث الفقهي بأنه مسئول عن حالة السلبية وعدم المبادرة، وعن ثقافة الخنوع التي
تلبست الأمة؛ بالمخالفة للشرعة التي ورثها القرآن لأتباعه؛ المبنية على ضرورة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلك الجراة في الحق التي بلغت بأحد الصحابة أن
قال لسيدنا عمر رضي الله عنه لو وجدنا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا. من محاولات
التجديد هذه أذكر مثلاً الدكتور حاتم المطيري في الكويت، وهو من الحركة السلفية
وكتابه “الحرية والطوفان”. فالكتاب يتهم مساحة عظيمة من الفقه بأنها سبب
في شيوع ثقافة الاستسلام عبر عدة سبل؛ منها إجازة إمارة الاستغلاب، وإجازة البيعة
بالإكراه تحت دواعي درء الفتنة. ما رأيكم في هذا التراث الفقهي؟ وفي محاولة
التجديد لتجاوزه؟
د. أحمد الريسوني: لا شك
في أن ثمة تضخمًا في أدبيات التسكين والتهدئة والاستسلام والتعايش مع الواقع، هذا
صحيح. هذا الجانب تضخم، ومن أسباب تضخمه؛ بطبيعة الحال؛ أن الدولة عادة ما تقرب
إليها زمرة من الفقهاء، فيكون هؤلاء الفقهاء أكثر استكانة، وأكثر تسكينًا للناس،
وأكثر ميلاً للآراء التي تحث على التهدئة والاستسلام وممالأة الحاكم والسكوت عن
ظلمه. هذا صحيح. ولا نستطيع أن نبرأ كافة علمائنا يعني عبر هذه العصور المديدة.
لكن.. مقابل هؤلاء دائمًا كان الرأي الآخر الموجود، وهو موجود في الكتب، ولكنه
ربما لكونه رأيًا معارضًا أو غير مرغوب فيه، عادة ما يكون أقل شهرة، وقد يكون
صاحبه أيضا محط اضطهاد وتضييق، وقد لا يضمن رأيه في كل كتبه، أو لا يضمنه بالدرجة
الكافية من الوضوح.. وغير ذلك.
هذه عوامل لها تأثير على
كل حال، ولكن في جميع الأحوال؛ إذا تتبعنا الرأي المجمع عليه نجده يتعلق بالسلاح.
ومع ذلك، لا أنكر أن هناك من توسعوا في مفهوم الطاعة والانضباط والخضوع، ودعوا
إليها بصفة عامة. وقد يفهم من كلامهم أنه لا يجوز بشكل من الأشكال معارضة أو
مناهضة حاكم معين. وهذا كله عند التحقيق يغدو غير صحيح. هي آراء صنعها واقع تاريخي
معين.
س: فضيلة الدكتور.. بالنظر
إلى المحاولات الفقهية المعاصرة لضبط فقه الاحتجاج، لم يكن هناك إقدام بارز على
تجاوز العقلية التي ورثت هذا الاتجاه الاستكاني الاستسلامي في الفقه، ولم يكن ثمة
حث وبعث وتزكية وإزكاء لثقافة الاستعداد لتحمل التكلفة الاجتماعية للتغيير، يعني
لم يراعَ في المحاولات التجديدية محاولة إيقاظ همة الناس. هلا أنرتمونا إن كان من
خاض في هذه المساحة من علمائنا المجددين. أنا لا أتحدث بالضرورة عن تعبئة الناس
للاحتجاج، ولكن أتحدث عن استمرار يقظة المحكوم ومراقبته لمسيرة السلطة لئلا تؤول
إلى حال فساد واستبداد. فهذه الثقافة تنقص العقل المسلم اليوم. ولم أر من فقهائنا
من أولاها القدر اللائق من الاهتمام؟
د. أحمد الريسوني: معك حق.
هذا الرأي صحيح، لكن له سياقه التاريخي. فكما نعرف جميعًا، نحن اليوم نعيش في ظل
ما يسمى بالدولة الحديثة، وقبلها كنا في مرحلة الاحتلال. مضت على الأمة الإسلامية
عقود عديدة قد تصل إلى قرن؛ تزيد أو تقل، مثلاً الجزائر رزحت تحت نير الاستعمار مائة وثلاثين من الاحتلال، ودول
أخرى عانت أقل من ذلك. فإذا أردنا أن نتحدث عن العصر الحديث، نجد أن علماءنا
اشتغلوا فترة من الزمن بفقه المقاومة، وراكموا فيه، وكانوا فيه واضحين، وأسعفتهم
النصوص الشرعية والنصوص الفقهية، ونظروا للمقاومة وأوجبوها وخاضوها وشاركوا فيها.
بعد ذلك دخلنا في هذه
الحقبة التي نعيشها الآن. هذه الحقبة يفسرها بعض الكُتاب بقوله صلى الله عليه
وسلم: “ثم تكون ملك جبريًا”. يرون أن ما نحياه هي حقبة الملك الجبري. في
هذه الحقبة يمكن أن أقر ما ذكرته. فالفقه إلى الآن؛ من حيث التعامل مع هذه الحقبة
وطبيعتها؛ لم يستقر بعد ولم ينضج.
هذه الحقبة تميزت بظلم
زائد، واستبداد زائد، وتعسف زائد لم تشهده الحقب السابقة. ففي الحقب السابقة على
سبيل المثال، لم يصل حاكم مثلاً إلى أن يلغي الشريعة بكاملها. هذا حدث اليوم في
كثير من الدول الإسلامية. فالآن؛ ذكر الشريعة، مجرد ذكرها، يعتبر شيئًا تثور لأجله
جهات وأقلام وحكام وأجهزة أمنية.. إلى آخره.
ولننظر إلى دعوة تطبيق الزكاة
مثلاً، الآن معظم الدول الإسلامية لا تطبق الزكاة. فالزكاة تعبير عن حقوق للفقراء
وحقوق للفئات الضعيفة، حقوق أتى بها الشرع كان منكرة ومجهولة. فقديم، برغم التسلط
والظلم والاستبداد في جوانب أخرى؛ كانت هذه الحقوق مضمونة، وكان ثمة نوع من
التوازن الاجتماعي يقع، وكانت هناك الأوقاف العظيمة المتعاظمة عبر العصور.
والأوقاف هي في الدرجة الأولى إنما هي للفقراء بشتى أشكالهم وأسمائهم: أيتام
وأرامل وذوي إعاقات وعابري السبيل والمشردين. الأوقاف كانت تؤوي هؤلاء وتطعمهم
وتشغلهم وتعلمهم وتنفق على تعليهم وتنفق على أساتذتهم وجامعاتهم. هذه الأمور كلها
اختلت الآن. الوقف لم يعد موجودًا إلا بشكل فردي، الزكاة لم تعد موجودة إلا بشكل
فردي، فمؤسسة الزكاة ومؤسسة الوقف، وعدد من الأمور التي لم يكن أحد يجرؤ على
وقفها، بل كان الجميع يتسابقون إلى خدمتها بما في ذلك الحُكام. ربما كان أولئك يغتصبون
الأموال في بعض الأحيان؛ ولكنهم أيضا كانوا يقفون أموالاً عظيمة على مختلف أوجه
الخير.
فالآن، صار عندنا اختلالات
أكبر من أي وقت مضى. وهو ما يحتم على الفقهاء أيضا أن يوسعوا بموازاة ما توسع من
الظلم والحيف. على الفقهاء أن يوسعوا من دائرة مقاومة هذا الظلم. لكننا نجد أكثر
الفقهاء ربما ما زالوا على الحالة القديمة، برغم أننا أمام دولة تسيطر على كل شيء،
وتمنع كل شيء تقريبًا، وتتحكم في كل شيء، وتعيد صياغة الحياة.
وهذا طبعًا عمق من دائرة
الظلم والاستبداد؛ لأن أدوات الاستبداد والظلم، الأدوات التشريعية الأمنية العسكرية
الاقتصادية، هذه الأدوات جميعها أصبحت بيد الحاكم بصورة رهيبة جدا، مما يحتم فعلاً
توسيع وتفعيل وتعديد آليات مقاومة مفاسد هذا الواقع الجديد. ولذلك فعلا نحن بحاجة
إلى فقه جديد من قبيل ما ينحو إليه الدكتور حاتم المطيري وغيره من فقهاء هذه
اللحظة التاريخية التي نعيشها.
س: فضيلة الدكتور.. لقد
تحدثت أو أظن أننا قمنا بتأويل بعض حديثك في كتابكم: الشورى، فذكرنا أن
الديمقراطية من وجهة نظر الدكتور أحمد الريسوني تحقق مقاصد الشريعة. فلو نظرنا
للقضية من زاوية المقابلة بين الاستبداد والديمقراطية؛ كيف يراها الدكتور الريسوني
من وجهة نظر نظرية المقاصد؟
د. أحمد الريسوني: طبعًا
أنا مع الشيخ ابن عاشور والشيخ علال الفاسي، وهم من علماء العصر المقاصديين، فيما
ذهبا إليه من أن الحرية مقصد شرعي. هذا لم يغب عن الفقهاء، لكن لم يصل إلى التصريح
به بهذا الشكل الواضح الجلي، وتسمية الأمور بأسمائها.
فالحرية حالة فطرية خلق
الله تعالى الناس عليها. وكل ما يخدمها، وكل ما يحققها هو بدون شك يسعى لتحقيق
مقاصد الشرع. كثير من فقهائنا – عند تعاملهم مع قضية الحرية – يتجهون إلى ضبط
الحرية وتقييدها إلى الآن، ويرون أن الشرع لم يأت بالحرية؛ وإنما جاء بضبط الحرية.
هذا صحيح نسبيا. فالشرع جاء بضبط الحرية، ولكن قبل أن يضبط الحرية هو يعطي الحرية.
لأنه بدون وجود حرية؛ ماذا يضبط؟
فالحرية هي الأصل. الحرية
الفردية والحرية الجماعية. الحرية بجميع أشكالها: حرية ضمير وتفكير وتعبير ومبادرة
وتظاهر واحتجاج وإبداع وبناء وإصلاح. ومنها حرية الإنسان في حياته الشخصية؛ أن
يتنقل ويفعل ما يشاء. هذه الحرية يجب إقرارها أولاً، وبعد ذلك يأتي التقييد؛ لأن
التقييدات دائمًا تكون في شيء مباح وقائم، وربما أفرط الناس فيه. التقييد يأتي
لمقاومة نوع من الإفراط والانفلات.
فإذن من هذا الباب أيضا؛
تأتي الديمقراطية كصيغة – بدون شك – صيغة جيدة، من أجود ما وصلت إليه التجارب
البشرية في إعطاء الحرية وفي تنظيم الحرية أيضا.
الديمقراطية تتضمن الحرية،
وتتضمن تقييد الحرية. ولذلك مرة سألني أحد الإخوة الصحفيين عن حدود الديمقراطية؛
على أساس أن الإسلاميين – عادة حتى من يقبلون الديمقراطية – يسألون أولا عن
حدودها، فقلت له: بالنسبة لي؛ لا حدود للديمقراطية إلا الديمقراطية نفسها. بمعنى
أن تقييد الديمقراطية وارد في الديمقراطية نفسها.
فأنا لا أحتاج حينما أطالب
بالديمقراطية، لا أحتاج أن أقول: الديمراطية بشرط ألا تناقض شيئًا في الشرع. لا هي
الديقمراطية تلقائيًا تعطيك آلية لتقييدها بما ورد في الشرع، وبما لم يرد في الشرع
أيضا، يمكنك أن تضع قيودًا لم ترد في الشرع، لكن بالديمقراطية نفسها، وليس بالتفرد
والاستبداد والتسلط.
لهذا أنادي دائما وأقول،
وقلت هذا مرارًا: لا داعي لإثارة هذه الشبهة حول الديمقراطية، من قبيل أن
ديمقراطيًا قد تلغي أحكام شرعية، وتحلل الحرام.. إلخ. لا، أبدًا، هذا لن يقع؛
وإلغاء الشريعة في هذا العصر – لحسن الحظ – لم يتم أبدًا بالديمقراطية. فليس هناك
أي تصرف ديمقراطي أو قرار ديمقراطي أدى إلى إلغاء حكم شرعي واحد في العالم
الإسلامي، وإنما ألغيت الشريعة بالاستبداد والانقلاب والجيوش والتسلط، ابتداءً من
أتاتورك، فأتاتورك لم يلغ الشريعة بالديمقراطية، وإنما ألغاها بانقلاب عسكري.
لذلك ليس هناك أي إشكال
حقيقي للشريعة مع الديمقراطية. والإشكال الحقيقي هو مع إفساد الديمقراطية
وتحريفها؛ مثلما هناك إشكال حقيقي مع إفساد الشرع نفسه وتحريف أحكامه لصالح
الاستبداد.
وبصفة عام، هناك ميل
لتحريف الأمور النبيلة والصحيحة عن مسارها وعن حقيقتها. وهذا يقع في الدين أكثر
مما يقع في الديمقراطية؛ لأن كل ما كان للشيء هيبة ومكانة، يحتال المحتالون لتأويله
لصالحهم.
س: فضيلة الدكتور.. تحدثت
في كتابك عن الشورى، فذهبت إلى القول بأنه لا مشكلة في أن نطلق على الشورى لفظة
الديمقراطية؛ طالما أن الألسنة تعارفت المصطلح، فهل هذا يعني أنك ترى أن
الديمقراطية هي الشورى، فيصبح لها – أي الديمقراطية – من الإلزام الثقافي والقوة
المعنوية ما لمفهوم الشورى مما أوصى به ربنا سبحانه وتعالى في الآيتين الكريمتين،
وما أوصى له نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المختلفة؟
د. أحمد الريسوني: أنا لم
أقل ولا أقول إن الديمقراطية هي الشورى، ولا أطلق لفظ الديمقراطية على الشورى. وقد
بينت الفوارق بين الشورى والديمقراطية في كتابي وفي غيره من المقالات. لكن، طبعًا،
هناك مساحة خاصة في القضايا العامة، أي في القضايا السياسية، وقضايا الشأن العام،
تلتقي فيها الشورى والديمقراطية. ما قلته هو أني لا مانع عندي من أن نستعمل مصطلح
الديمقراطية، وأن نعتمد الديمقراطية، وأن ننادي بالديمقراطية، باعتبار أن
الديمقراطية بالنسبة لي هي جزء من الشورى.
الديمقراطية عندي جزء من
الشورى. الشورى أعم. الشورى تكن في الحياة الفردية والحياةالدينية والحياة
العائلية. الشورى قد تكون في الزواج وفي الطلاق، وتكون في البيت وفي غيره، وفي كل
شيء. الشورى أوسع بكثير. والشورى خُلق حتى لو لم يكن الإنسان مضطرًا إليها ولم تكن
واجبة عليه فتكون مندوبة في حقه، ويكون له فيها فضل وأجر، بمعنى أن يكون صاحب خلق
كريم إذا كان يستشير. وهذا لا دخل له في الديمقراطية، ولا دخل للديمقراطية فيه.
فإذن.. المجال الذي تحكمه
الديمقراطية وتدخله الديمقراطية هو جزءٌ مما تحكمه الشورى وتدخل فيه الشورى، وما
دامت الديمقراطية تحديدا في جوهرها ليس فيها إشكال من الناحية الشرعية، فلا مشاحة
في الاصطلاح كما يقول علماؤنا، أنا لا أتشاح في الألفاظ، أنا أتشاح في المقاصد.
فمقاصد الشورى ومقاصد الديمقراطية تلتقي، أو بعبارة أخرى مقاصد الديمقراطية موجودة
بالكامل ضمن مقاصد الشورى.
فإذن لا مانع عندي، وليس
عندي حساسية من استعمال لفظ الديمقراطية، بل ليس عندي حساسية من أن أوصف بأنني
ديمقراطي مثلاً. أنا ليست معنيًا بهذا الوصف؛ لأن عندي ما يكفي من الأوصاف لأصف
بها نفسي، لكن من أراد أن يصفني بأني ديمقراطي التفكير أو النزعة أو ما إلى ذلك؛
فلا مانع ولا حساسية عندي مع لفظ الديمقراطية؛ لأني أنظر إلى المضمون، والمضمون
مقبول تمامًا.
س: فضيلة الدكتور سؤالي
الأخير.. بالنظر لوقتكم؛ الديمقراطية تتضمن – فيما تتضمن – قيمة مساءلة الحاكم
وقيمة مراقبته. فهل تتضمن الشورى هاتين القيمتين في بنيتها، أن يكون من حق المحكوم
أن يساءل الحاكم، وأن يراقب تصرفاته. أنا أطرح هذا التساؤل بالنظر إلى أنك وصفت
الشورى بأنها الأعم، وأنا أشعر أن الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل منكم بالنسبة لها.
د. أحمد الريسوني: في الشورى؛ أهم آية وأعم آية في
الشورى هي (وأمرهم شورى بينهم). فهي تتحدث عن المسلمين قاطبة، بخلاف آية (وشاورهم
في الأمر)، وإن كان إذا جمعنا بين الآيات والنصوص وهذا هو الواجب ليس هناك أي
إشكال.
هذه الآية (وأمرهم شورى بينهم) تعني أن كل ما هو بيننا
وما هو من أمرنا، وما هو مشترك بيننا حتى لو كان شخصين، حتى لو كنت أنا وأنت في
سفرٍ أو في عملٍ فأمرنا شورى بيننا، في كل ما هو مشترك بيننا.
فمن هنا الشورى أعم من الديمقراطية، لكن الذي تسأل عنه
هو شيء آخر، المحاسبة والمراقبة موجودة عندنا في عناوين أخرى وفي أبواب أخرى. ومما
ذكرته أيضا في الكتاب وفي غيره، أن الديمقراطية أكثر غنًا بتجاربه التطبيقية، هذا
لا شك فيه. وأنا أوضحت في الكتاب أيضا في كتاب “الشورى” أن تجربتنا
الشورية عبر التاريخ ضعيفة، حيث همشت أو أقبرت أو قلصت دوائرها. وهذا أفقدها التجربة
التطبيقية المتنوعة والمتأججة، بينما الديمقراطية تجاربها سواء في القديم أو في
القرون الأخيرة في الدول الغربية، ثم الآن
في العالم كله تجاربها العملية والميدانية كثيرة.
فإذن الربط بين الديمقراطية وأجهزة المحاسبة والمراقبة،
واعتبار مثلاً أن المؤسسات التشريعية ونحوها، أو حرية الصحافة كجزء من النظام
الديمقراطي، هي وسائل ضرورية للمراقبة، والمحاسبة، هذا بدون شك شيء جيد، وموجود في
الإسلام، ولكن ليس تحت عنوان الشورى، وليس تحت تجربتنا الشورية تحديدًا، بل في
أبواب فقه تغيير المنكر وإنكار المنكر والمحاسبة، وثمة وظائف عديدة نشأت في هذا
الصدد، لكن ليس تحت عنوان الشورى هذا هو المقصود. فإذن ما تتضمه الآن الديمقراطية
من محاسبة ومراقبة شيء شرعي، شيء واجب، وشيء مطلوب، ولكنه لم يأت تحت عنوان
الشورى، هذا هو الفرق فقط.