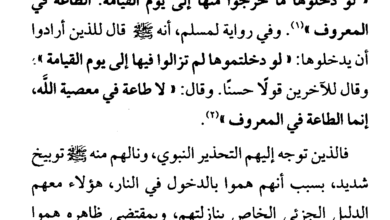الديمقراطية من منظور إسلامي

الديمقراطية من منظور إسلامي
لا شك في أن هذا الموضوع هو موضوع كثر فيه الحديث وطال وتعدّدت فيه الكتابات والمؤلفات، ولا تكاد تخلو اليوم مجلة أو جريدة معنية بالقضايا الإسلامية وبالفكر الإسلامي والفقه الإسلامي، إلا وتجد لها معالجات وتناولات لهذا الموضوع، ولا تكاد تخلو اللقاءات السياسية والتنظيمية من تطرق لهذا الموضوع أو لبعض زواياه، ولذلك لم أجد من المناسب أن أتحدث فيه بطريقة تقليدية وشمولية، لأن هذا سيجعل الكثير من الكلام مكرّراً ومستثقلاً، ولذلك اخترت أن أتحدّث حديثاً انتقائياً، يكون أقرب إلى إثارة جوانب أرى أنه من المفيد أن نزيد فيها الحوار والنقاش، فلن أتناول الشورى والديمقراطية بالمقارنة من ألفها إلى يائها، وإنما أنتقي نقاطاً وقضايا في تقديري أنها هي الأحق بالإثارة والأفيد في مقامنا هذا.
فمنذ نحو قرن تقريباً، ومنذ طفت الديمقراطية الغربية على السطح، وبسطت شعاراتها وراياتها على العالم، وعلى العالم الإسلامي بصفة خاصة، وعلماؤنا ومؤلفونا وفقهاؤنا ومفكرونا يكتبون ويعالجون ويقارنون ويفتون ويمايزون وينتقدون أو يرحبون. فهناك إذن ركام كبير موجود في هذه المسألة.
أولاً: حكم الشعب نفسه بنفسه
أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية هي القضية المعبر عنها في هذا الاسم نفسه وفي هذا المصطلح نفسه، وهو أن الديمقراطية تعني سلطة الشعب أو حكم الشعب، أو إذا أردنا توضيحاً أكثر وكما تعني الترجمة الحرفية فالديمقراطية هي: حكم الشعب نفسه بنفسه.
ونحن نعرف من الناحية الإسلامية أن حكم الناس بأوسع معاني الحكم بمعنى تسيير شؤونهم والتشريع لهم والأمر والنهي في حياتهم، وحفظ مصالحهم… ينقسم إلى قسمين: هناك ما هو منصوص ومنزل، وهناك مجال واسع بل لا حد له متروك لتدبير الناس أنفسهم، ولذلك يمكن أن نقول: إن الحياة الإسلامية -كما هو معروف- تسير على سكتين متوازيتين ومترافقتين جنباً إلى جنب وهما النص والاجتهاد، الوحي والاجتهاد.
فيما يخصّ الوحي لا شك في أن المسلم يعرف أن النص – ولا سيما إذا كان ثابتاً ثبوتاً لا نقاش فيه وواضحاً بدلالته بشكل لا غبار عليه- هاهنا نقول: إنِ الحكم إلا لله، وإذا قضى الله ورسوله أمراً فلا خيار لمؤمن ولا مؤمنة مع حكمه، برضا وطواعية. وهنا لا مجال للشورى.
أما ما سوى ذلك مما فيه نص لكن مع بقاء مجال للنظر، في ثبوت النص، أو في دلالته وتفسيره، أوفي تنزيله وتحقيق مناطه، أو كان مما لا نصّ فيه، هاهنا ينفتح المجال للنظر والاجتهاد والتقرير لكل من له دراية وخبرة بالموضوع.
ثم إذا رجعنا إلى ما هو منصوص وتقرّر بأنه لا حكم فيه لنا والحكم فيه لنص الشرع، وقد حكم فيه، في هذا المجال أيضاً نجد مجالاً لنوع من الاجتهاد، وهو الاجتهاد في التطبيق والاجتهاد في التنزيل. فإذا وجدنا مثلاً في الزكاة حكماً نصياً لا يملك أحد أن يجتهد فيه ولا أن يلغيه ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه، سواء تعلق الأمر بمقاديرها أو بمستحقيها أو ما إلى ذلك من الأمور المنصوصة، فإن ممارسة هذا العمل وتطبيقاته يفسح المجال فيها لكثير من الاجتهادات التي تحتاج إلى التداول والتشاور والرأي والخبرة والتجربة. فماذا نفعل بأموال الزكاة في انتظار أن توزع، من الممكن أن نأخذها ونوزعها توزيعاً فورياً ومع ذلك تبقى أمامنا أموال فائضة، هنا يمكن أن ينفتح المجال أيضاً للاجتهاد، هل نستثمرها؟ هل ندخرها ونجمدها؟ هل نُقرض منها… إلخ، ثم هؤلاء الذين سماهم القرآن العاملين عليها كيف يعملون؟ هل كل فرد يعمل بمفرده، هل هذا مجال يتحكم فيه شخص بمفرده؟ هل يتشاورون، هل يتداولون، في كثير من الجوانب الإدارية والتقنية والحسابية والمالية. ففي أي مجال: في الحدود، في نظام الأسرة، سنجد حين التطبيق أن هناك مجالاً للشورى، ومجالا للاجتهاد والتداول. بل إن القضاة – وهذا من جميل أعرافنا- قد نص الكثير من الذين كتبوا في القضاء، أن القاضي لا بد له من أن يتشاور. وقد أصبح هذا في كثير من الحالات نظاماً ملزماً. ونظام التشاور كان قد أصبح في الأندلس نظاماً قاراً. ونجد في تراجم بعض العلماء أن فلاناً كان مشاوراً أو يوصف بـ”الفقيه المشاوَر”. فالقاضي لا بد له من أن يتشاور، والتشاور هو نفسه يؤسّس لما عرفه العالم في وقت متأخر وحديث من نظام القضاء الجماعي. فالمفروض في القضاء الإسلامي نفسه أن يطبّق الأحكام المنصوصة قبل أن يصل إلى الاجتهاد وأن يطبّق ذلك بنوع من الشورى والاجتهاد. وهكذا نرى أنه إذا كنّا نقسم حياتنا ومشاكلنا وقضايانا وما نحتاجه من تشريعات وأحكام إلى ما هو منصوص، وما فيه اجتهاد أساساً وبداية، فإنّ ما هو منصوص أيضاً فيه مجالات للاجتهاد والشورى.
هذه المجالات التي تدخلها الشورى كلّها تقبل أن نقول فيها: إن الناس فيها يتدبّرون أمرهم ويحكمون أنفسهم بأنفسهم. طبعاً حينما يحكم الناس أنفسهم بواسطة العلماء وبواسطة القضاة، وبواسطة حكام وأمراء منتخبين ومختارين ويرضى بهم الناس، فإنّ الناس حينئذ إنما يحكمون أنفسهم بأنفسهم، وإلا فلا يوجد في التاريخ شعب حكم نفسه بنفسه بالمعنى الحرفي والظاهري لهذه الكلمة. فـ “الشعب يحكم نفسه بنفسه”، معناه أن الشعب يختار من يحكمه ويختار النظام الذي يحكمه، ويختار من يقرّر له، ويختار من يدبر أمره. فبهذه الكيفية نقول: إنه حينما يحكمنا ناس نختارهم، وحينما يحكم علينا قضاة نرتضيهم، وحينما يقودنا ويجتهد لنا علماء نتبعهم وننقاد لهم ونثق في كفاءتهم، فحينئذ نكون أيضاً نحكم أنفسنا بأنفسنا.
نعم، الإسلام هنا يختلف اختلافا جوهريا، وهو أن له مرجعية، وأما الديمقراطية فليست لها في الغالب مرجعية سوى الديمقراطية نفسها. بمعنى أنه حتى حينما نختار من يحكمنا فإننا نختاره ليحكمنا بمرجعية نتفق نحن وإياه على الإيمان بها وعلى الأخذ بها. وحين نختار من يجتهد لنا ويقرّر لنا ويبحث في الأمور ويضع لنا التشريعات فإننا نختاره ونحن وإياه مستحضرون ومستصحبون لمصادر هذا الاجتهاد وحدوده وسننه وشروطه، بينما الديمقراطية ليست لها مرجعية سوى ما يتقرّر في هذه الديمقراطية نفسها، هي نفسها تقرر مرجعيتها إن أرادت أو لا تقررها، أو تقررها ثم تمسحها وتلغيها، أما بالنسبة إلى الإسلام فليس الأمر على هذا الإطلاق وليس بهذا الفراغ الكامل، وإنما هناك ضوابط وهناك ثوابت وهناك مرجعية، وإن كان حتى في بعض الديمقراطيات الغربية، نجد مبادئ وثوابت مرجعية محدّدة ومقيدة للممارسة الديمقراطية.
ثانياً: الحكم بواسطة الأغلبية
كذلك من المبادئ الأساسية في النظم الديمقراطية كما نشأت وكما تطوّرت مسألة الحكم بواسطة الأغلبية؛ لأنه حين يقال: حكم الشعب نفسه بنفسه أو “الديمقراطية هي حكم الشعب أو سلطة الشعب” فهذا لكي يطبق عملياً يلزم أن يكون في كل ما تقرّر إجماع، وإجماع الشعب (بمعنى 100 في المئة) لا وجود له أبداً. فحتى حينما يُتحدّث أحياناً ويقال إجماع وطني في كذا، فالمراد به أغلبية كبيرة جداً، وإلا فكما يقال الآن في المغرب إجماع وطني حول قضية الصحراء، طبعاً هناك شواذ من الناس لا يؤمنون بهذا الأمر، ومع ذلك هذا لا يلتفت إليه ويعبر بالإجماع، نقول أيضاً: إن الشعب المغربي مجمع على الإسلام وعلى تطبيقه وعلى المطالبة به وعلى الإيمان به، ولكن هذا الإجماع ليس بنسبة (100 في المئة) فهناك ناس ملحدون، وهناك ناس غير مسلمين أصلاً. فكذلك حين نقول: إن الشعب يحكم بنفسه ويتّخذ القرار بنفسه، فهذا يعني عادةً الأغلبية، وهذه الأغلبية تقلّ وتكثر، والأغلبية يراد بها ما فوق (50 في المئة) وأقل من (100 في المئة).
فالديمقراطية إذا لم تعتمد مبدأ الإجماع الذي يكاد يكون مستحيلاً، بل هو في حق شعوب بكاملها مستحيل، استحالة واقعية، فالإجماع الحقيقي إنما يتصوّر في جماعة محدودة معدودة.
من هنا جاء مبدأ تحكيم الأغلبية على أساس أنه أصبح عماد النظام الديمقراطي. وفي مبدأ الأغلبية يمكن أن نقول: إن مشروعيته ثابتة من الناحية العقلية. وما ثبتت صحته من الناحية العقلية السليمة فهو يكتسب في نظرنا الشرعية الإسلامية؛ لأنه حين يختلف الناس فلا يكون أمامنا إلا واحد من أمرين: إما أن نأخذ برأي الأغلبية فنحكم به الأقلية، أو أن نحكم بالأقلية على الأغلبية، فلا بديل عن الحكم بالأغلبية إلا الحكم بالأقلية. وهنا نظن أن الرجحان واضح: إذا كان حق الأقلية هو حق 20 فلا شك في أن الآخرين لديهم حق 20 + الفارق العددي بينهما. فهاهنا تُرجح الأغلبية لأنه لا بديل عنها.
كثير من الناس يقولون: إن الأغلبية ليست معصومة، وهذا صحيح، ولكن ما البديل عنها، وهل الأقلية معصومة؟ فالتوقّف غير ممكن؛ لأن الحياة لا تتوقّف ولا بد من أنه سيمضي أحد الأمرين: الذي سيكون مقبولاً من لدن الأقلية أو الأغلبية.
فلأجل هذا أخذت الديمقراطية مبدأ الأغلبية، وأن حكمها نافذ على الأقلية، مقابل هذا هناك مبدأ مكمل له وضامن لمعقولية المبدأ الأول، وهو حق الأقلية في أن تخالف وتعارض بالرأي وتجاهر بالمخالفة وتمارس ذلك وتستمر عليه ما شاءت أن تستمر أي: “حكم الأغلبية مع ضمان حق الأقلية في المعارضة وفي المخالفة والتعبير عن ذلك”.
وإذا رجعنا إلى ديننا وتراثنا وإلى نصوصنا، سنجد أن مبدأ الاحتكام إلى الأغلبية قد عمل به وأخذ به، ولو لم يكن قد عمل به بالدرجة نفسها أو بالكيفية نفسها ولا حتى بالاسم نفسه أحياناً. لدينا إشارات ونصوص عدّة تشير إلى أن مبدأ الأغلبية – لكن بشروط إسلاميّة تجعله أكثر ضمانة وسلامة- مبدأ موجود؛ لأنّه دائماً في هذه المبادئ – كما نرى- الديمقراطية تأتي لتضع بعض الضمانات، فبالرغم من أنها من دون مرجعية، إلا أنّها هي نفسها تنتج مرجعية. ففي مبدأ الأغلبية ولكي لا تتعسّف هذه الأغلبية وتتحوّل مثلا إلى “دكتاتورية البروليتاريا” كما يقول الماركسيون، قالوا: إن الأقلية لها الحق في أن تعارض وتخالف وتبدي رأيها، فهناك نوع من البحث عن ضمانات، ففي الإسلام أيضاً هذا المبدأ معمول به وضماناته أكبر.
نجد على سبيل المثال أنه حين بويع أبو بكر رضي الله عنه، بويع بما يشبه الإجماع ولم يبايع بالإجماع، فمنذ اليوم الأول بقي عدد من الصحابة ومن غير الصحابة لا يرون هذه البيعة صحيحة، ومنهم من يراها صحيحة مع أفضلية فلان أو فلان، فالذي ولّى أبا بكر ليس هو الإجماع، وإنما بايعته الأغلبية وانقادت له الأمة. وهكذا بالنسبة إلى كل الخلفاء الراشدين، فليس هناك خليفة بويع بالإجماع واختير بالإجماع من أول يوم. نعم الإجماع قد يحصل فيما بعد حينما يستتب الأمر فيكون التسليم من الناحية العملية وليس التسليم بالرأي. وحتى من الناحية العلمية والفقهية كثيراً ما نجد أموراً يقال فيها: “رأي الجمهور”، ويرجح هذا الرأي في كثير من الحالات لمجرد أنه قول الجمهور، والجمهور هو تعبير شبيه بما يقال له اليوم الأغلبية، أو جمهور الأمّة إذا تعلق الأمر بالأمّة، أو جمهور العلماء في المسائل العلمية والفقهية المتخصّصة، وكثير من العلماء يرجّحون رأياً لمجرد أنه قول الجمهور، خاصّة إذا تقاربت لديهم الأدلة.
بل إن كثيراً من العلماء ومن الأصوليين نصّوا صراحةً على أن من المرجِّحات أن يكون القول قول الأكثر، سواء كان من الفقهاء أو حتى من الرواة إذا اختلفت روايتان وتعارضتا. كثير من المحدّثين والعلماء يرجّحون الرواية التي عليها الأكثرون من الصحابة أو من التابعين، على الرواية التي يرويها واحد أو اثنان؛ ولذلك كان الإمام مالك يأخذ بعمل أهل المدينة، وقبله فقهاء أهل المدينة أنفسهم، يرجّحونه على الرواية الأحادية أو الحديث الآحادي، وكما كان يقول أحدهم وكما شاع عنهم: “رواية ألف عن ألف خير من رواية واحد عن واحد” أو “ألف عن ألف خير من واحد عن واحد”، وهذا معناه أن الرواية التي كثر رواتها راجحة عن الرواية التي قلّ رواتها. وكذلك في الفقه ينصّ كثير من الأصوليين والفقهاء على أن الكثرة: كثرة الفقهاء وكثرة القائلين مرجّح، ونحن نعلم كيف أنّ عمر رضي الله عَنهُ حينما عهد بالبحث فيمن يخلفه، عهد بالأمر إلى من عرفوا باسم الستة أصحاب الشورى، وهؤلاء اختيروا بشكل تلقائي لأنهم آخر من بقي ممن توفي رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم وهو راضٍ عنهم بالتسمية والتصريح، (وإلا فهو راض ضمنياً عمّا لا يُحصى من الصحابة). فحين عهد إليهم عمر بأن يختاروا خليفة تبايعه الأمة بعد ذلك، حلّ القضية بتحكيم الأغلبية، فقد كانوا ستة ومعهم ولده عبد الله، لكنّ عبد الله خارج من الترشيح، فهؤلاء يختارون من بينهم لأنّهم أفضل من يختار وهم أفضل من يُختار، ولكي يبعد عن نفسه الشبهة وعن ولده فقد قال لهم: إذا اتفقتم ثلاثة ثلاثة فهنا يكون دور عبد الله بن عمر مرجِّحاً، فيصبح أربعة ضد ثلاثة فهنا كذلك تثبيت لقاعدة الترجيح بالأغلبية.
ثالثاً: فصل السلط
المبدأ الثالث الذي أصبح من أركان النظم الديمقراطية هو فصل السلط، والمقصود هنا بالسلط هو السلط الثلاث: السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، فأيّ نظام حكم تقريباً ومنذ قرون أصبح لا بد له من أن يحكم الناس بواسطة تشريعات يصدرها ويعرفها الناس ويلتزمون بها، ثانياً: السلطة القضائية تطبّق هذه الأحكام على النزاعات بين الناس وتصدر أحكامها بأنّ النازلة الفلانية أو الفعل الفلاني والتصرّف الفلاني ينطبق عليه القانون الفلاني ويلزم فيه كذا، ويصدر الحكم القضائي بذلك. ثمّ هناك السلطة التنفيذية التي تباشر التدبير العام للأمّة وللدولة وتنفّذ حتى الأحكام القضائية نفسها.
نجد أحياناً من يعترض على هذا المبدإ ويقول: ليس هناك في الإسلام فصل للسلط، وأن الخليفة كان يمارس القضاء وينفذ ويفتي، فيمارس نوعاً من السلطة التشريعية، وأن الرسول صلّى اللهُ عليه وسلّم كذلك جمع السلط… إلخ. ولكن إذا نظرنا في تاريخنا منذ بدايته نجد أن فصل السلط بدأ منذ وقت مبكر، ثم نما واتسع باتساع الحياة وتعقّدها؛ لأنّه فصل السلط إن كان اليوم يطرح على أساس أنّه يقسّم السلط تجنّباً لتكدّسها في يد واحدة وفي قبضة واحدة، فإن هناك شيئاً آخر يقتضي هذا الفصل، وهو أن كل شيء ينمو ويتضخّم -حتّى وإن لم نخش فيه الاستبداد- يكون طبيعياً أن يقسم، فالإنسان الذي يملك مدرسة وهي عبارة عن قسم واحد، يمكنه أن يكون هو المدير وهو الحارس العام وهو المعلّم وهو الذي يتكلّف بفتح وإغلاق المدرسة، لكن عندما يصبح هناك عشرة أقسام أو عشرة مستويات، يصبح من الضرورة إحداث نوع من فصل السلط، بإسناد كل منصب لشخص ما، فيكون صاحب المدرسة مرغماً على تسليم بعض سلطه، وإلا سيعجز عن التسيير، فعلى الأقل هذا الاعتبار يفرض تقسيم عدد من المسؤوليات كلّما نمت وتشعّبت، وكما قال عمر بن عبد العزيز: “تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور”.
في البداية كانت الأمور بسيطة، والرسول صلّى اللهُ عليه وسلّم، لا يقاس عليه الناس في كل شيئ، ولكن يستأنس ويقتدى به، وقد مارس صلّى اللهُ عليه وسلّم الإفتاء وكان يقضي بين المتخاصمين في حالات ونوازل عديدة، ويشرف على التنفيذ. ولكن في حياته صلّى اللهُ عليه وسلّم بدأ نوع من الفرز والاختصاص وظهر ذلك بشكل جلي سنة بعد أخرى، من أيام الخلفاء الراشدين إلى مَن بعدهم، وأصبح الجهاز القضائي مستقلاً ومتميّزاً بصلاحياته. والسلطة التي نسمّيها الآن “سلطة تنفيذية” أيضاً أصبحت متميّزة بصلاحياتها ومجالاتها، صحيح أن المجال التشريعي بقي تارة يمارس من طرف السلطة التنفيذية في مجال، وتمارسه السلطة القضائية في مجال، باعتبار أن القاضي في الأصل يشترط عند المسلمين أن يكون عالماً مجتهداً، فإذا كان كذلك بهذا الشرط أولاً، وكانت له أحكام وقواعد وأدلة مرجعية يلتزم بها، هنا آفّة أن يصبح مشرّعاً بهواه طاغياً بتشريعه يكون مجاله ضيّقاً ومحدوداً؛ ولذلك لم تكن مشكلة أن يمارس القضاة نوعاً من التشريع وتصبح اجتهاداتهم ضرباً من التشريع الاجتهادي. فالسلطة التشريعية فقط هي التي ظلّت غير مفصولة تماما، وإلا فالسلطة التنفيذية والقضائية افترقتا من وقت مبكر. وهذه المسألة تأتي أولاً بالنمو والتضخم والتعدّد في التبعات والمسؤوليات، ثم إذا ثبت فعلاً أن هناك نوعاً من الاستبداد ونوعاً من الاحتكار ونوعاً من التحكّم والتسلّط في بعض فئات المسؤولين، فإنّه من عين المصلحة تقسيم السلط وتوزيعها، لتجعل بينها نوعاً من التوازن لمصلحة الناس. وقاعدة سد الذرائع تقتضي ذلك.
على كل ففصل السلط عُمِل به بأشكال عدة في تاريخنا، ويمكن أن يُعمل به بأشكال أخرى أكثر ولا مانع في ذلك؛ لأنّ ما يحقّق العدل أكثر والمصلحة أكثر والنزاهة أكثر والتوازن أكثر، ثمّ ما يوزّع هذه المسؤوليات بحيث يتقاسم أعباءها عدد متزايد وعدد أكبر من الناس بدلاً من أن تثقل كاهل عدد محدود من الناس يعجزون عنها، فذلك من العدل ومن الحكمة ومن المصالح المعتَبَرة في الشرع.
هذه أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية مع شيء من المقارنة.
رابعاً: بعض الإشكالات المرتبطة بتطبيق الديمقراطية
هناك إشكالان رئيسان لدى بعض المسلمين، مفكريهم وعامتهم وحركاتهم:
- الإشكال الأول: قولهم بأن الديمقراطية نظام نبت في تربة وفي بيئة غير إسلامية، بل في البداية نبت في بيئة وثنية، ثم انبعث في بيئة مسيحية، والآن هو آت من بيئة لائكية لا دينية، فهي إذن بدأت بالوثنية وآلت إلى أحضان اللادينية والإلحاد. فهي تتراوح بين الشرك والوثنية، كما بدأت في أثينا عند اليونان، وبين نفي الدين وإبعاده، كما آل أمرها الآن عند الدول وعند السياسيين الغربيين، ويقولون: إنّ هذا النظام الذي عاش وتنقّل ما بين شرك وإلحاد، هو مثقل بهذه النظرة الإلحادية وبهذه المرجعية الوثنية أو اللادينية. فنقله إلى العالم الإسلامي وإلى المسلمين أو التعامل معه أو الأخذ منه لا ينجو أو لا يخلو من هذه البصمات أو اللوثات.
ويزيدون فيقولون: وفوق ذلك كلّه نحن في غنى عنه “بنظام الشورى”.
- الإشكال الثاني: أن الديمقراطية التي تحكم الأغلبية وتجعل الأغلبية مشرعة “تحلل وتحرم” – باستعمال الاصطلاح الشرعي- يمكن أن تُحلّ ما حرّم الله وأن تحرّم ما أحلّ الله، وأن تلغي ما أوجب الله، وأن تفرض ما لم ينزل الله به سلطاناً. بمعنى أنّنا ننصب الأغلبية شارعة أو مشرّعة حاكمة، وكما يذهب بعضهم إلى درجة أنه يقول: كيف إذا حكمت الأغلبية بإباحة الخمر أو الزنا مثلاً… إلخ.
أما الجواب عن الإشكال الأول فإنّ الديمقراطية بنشأتها في بيئة وثنية، ثم بيئة مسيحية، لتصبح في النهائية علمانية، يدلّ على أن الديمقراطية لا دين لها، فلو كانت تلك الرواسب البيئية ملازمة لها لاقتضى الأمر أن الغربيين يأخذونها أيضاً بالوثنية اليونانية التي ولدت في أحضانها بآلهتها المتعددين، وبصراع الآلهة، وبالطبقية وإقصاء فئات واسعة من المجتمع… إلخ، والحال هو أنّ الفكرة الجوهرية انتقلت وخلّفت وراءها كثيراً من الأمور. هذا الانتقال من الحالة الدينية الوثنية إلى الحالة اللادينية هو وحده كاف للدلالة على أنّ الأفكار الأساسية للديمقراطية يمكن أن توجد وأن تنتقل من دون أن تنتقل معها وثنياتها أو لوازمها أو رواسبها. فهذا النقل وهذا التلازم نحن نفرضه في عقولنا فقط، وإلا فالعالم كلّه – على اختلاف أديانه ومذاهبه الدينية واللادينية – يدّعي الديمقراطية وينتسب إلى الديمقراطية. فالنظم الشيوعية والاشتراكية إلى الآن تضع في أسماء دولها كلمة “الديمقراطية الشعبية”، هذا يدلّ – إذا كان الأمر يحتاج إلى دلالة- أنه ليست هناك أمور لازمة لا تفارق الديمقراطية، بل حتى الدول التي يمكن القول: إنها الأكثر تمثيلاً ومصداقية في موضوع الديمقراطيّة هي نفسها بينها اختلافات عدة سواء في موضوع الدين أو في غيره، فهناك دول غربية ما زال للدين أثر ما في حياتها ونظامها السياسي كأمريكا وإيطاليا، وهناك دول أكثر تجرداً من الدين وبعداً عنه، كالدول الإسكندنافية.
فهذه الأمور التي نعتقد أنها من لوازم الديمقراطية ليست من لوازمها في الحقيقة، فيمكن إذاً أن تنتقل جملة من المفاهيم ومن الأفكار ومن المبادئ الديمقراطية من دون أن ينتقل معها كل ما لازمها في دولة معينة أو في حقبة تاريخيّة معينة.
كذلك إذا نظرنا نظرة تاريخية، فسنجد حتى الدول التي لم تعرف كلمة الديمقراطية عرفت أشكالاً من الممارسات ومن التدبير والتسيير، يمكن لأي واحد أن يصفها بأنها ممارسات ديمقراطية، ويمكننا أن نسقط كلمة ديمقراطية ونسميها ممارسات تشاورية أو تشاركية، فمعظم القبائل والشعوب التي عرفت نظماً قبلية عرفت نوعاً من الديمقراطية والشورى. حتى العرب في الجاهلية كانوا يمارسون نوعاً من الديمقراطية أو الشورى، فيعقدون ندواتهم واجتماعات مشايخهم، حتى قريش أثناء صراعها مع الرسول صلّى اللهُ عليه وسلّم كانوا يجتمعون ليقرّروا ماذا سيصنعون. فالديمقراطية البسيطة هي أن الناس النافذين في القبيلة وفي البلدة يجتمعون ويتداولون… أو إذا كانت البلدة صغيرة، فتجتمع على نطاق واسع، بحيث ينادي في الجميع فيجتمعون ليقرّروا في شؤونهم.
فهذا كان موجوداً عبر التاريخ، إلا أن اليونان قد اشتهرت في هذا المجال؛ لأنها خلّدت حياتها وتاريخها الفكري والسياسي بالمؤلفات والكتابة… إلخ. حتى أصبحنا نعرف التجربة اليونانية والأساطير اليونانية والتراث اليوناني على نطاق واسع. بينما هناك شعوب كثيرة في وأفريقيا أو آسيا مارسوا الديمقراطية، وتراثهم مليء بالممارسات التي إذا قارناها بالممارسات اليونانية التي اشتهرت باسم الديمقراطية سنجدها في جوهرها مثلها أو ربما أرقى وأكثر ديموقراطية منها؛ لأنه كما نعرف الديمقراطية اليونانية كانت تستبعد النساء من الممارسة الديمقراطية، وتستبعد الفقراء أيضاً والرقيق، فكانت تستبعد ثلثي المجتمع أو ربما ثلاثة أرباع المجتمع، بينما في قبائل عدة لا نجد هذا الاستثناء أو لا نجده بهذه الكيفية، ففكرة الديمقراطية إذاً أو فكرة التشاور والتدبير الجماعي للأمور والأخذ بالرأي الجمهوري، أي رأي الجمهور، كل هذه ممارسات نجدها في التاريخ البشري في آسيا وفي أفريقيا قبل الإسلام وبعد الإسلام. والتراث العربي قبل الإسلام مليء بالتنويه بالممارسات الشورية والتشاور وبأن الفرد ينقاد مع جماعته ومع قبيلته، ولو أنّ ذلك قد يخرج عن حدود الحق كما قال الشاعر:
إن أنا إلا من غُزَيَّةَ إن غوت غويتُ وإن تَرشُدْ غزيةُ أرشُدِ
فهو مع قبيلته فيما تختاره، غوت أو رشدت.
فبغض النظر عن الأسماء وبغض النظر عن نموذج معين، فهذه الممارسة في جوهرها موجودة، وهي نزوع بشري تلقائي تمليه التجربة ويمليه الواقع ويمليه التعقّل. فجاءت النظم الديمقراطية الحديثة فطوّرت وأنضجت ونظّمت، كما جاء الإسلام قبل ذلك فأضفى على الشورى قداسة وشرعية ووضعها في مصاف المبادئ الكبرى، وجعلها ضمن أركان الدين مذكورة مع الصلاة ومع الزكاة ومع الإيمان كما في سورة الشورى، وقد فهم ذلك علماؤنا كما قال القاضي عبد الحق بن عطية في تفسيره لآية الشورى: “والشورى من قواعد الإسلام وعزائم الأحكام”، فأضفى الإسلام بذلك على الشورى مرجعية وقداسة، وإلا فالممارسة كانت موجودة بشكل أو بآخر.
الإشكال الثاني: هو “أننا في تحكيمنا لرأي الأغلبية يمكن أن نلغي الإسلام كله”، جوابه ما يلي:
أولاً: إن الأغلبية – على الأقل في العالم الإسلامي– ستقف دائماً وأبداً مع الإسلام ومع أي حكم إسلامي ثابت يقول به العلماء ويوضحونه وينادون به، هذا من الناحية الواقعية. وإلا فمن لديه شك في ذلك فليأتنا بعكسه. فقد أكّدت التجارب أنّه حيثما أعطيت حرية الاختيار في العالم الإسلامي كان الاختيار يتجدّد ويتجذّر لصالح الإسلام، ويمكننا أن نتحدّى أي حاكم في العالم الإسلامي وفي غير العالم الإسلامي، أي سياسي، وأي لائكي، نتحدّاه أن نجرب ونستفتي الناس في حكم بعينه أو في مجموع الأحكام، كأنّ نقوم باستفتاء مثلاً في مسألة تطبيق الشريعة، فإذا كان استفتاءً حرّاً حقيقياً من دون إشهار ومن دون حملة انتخابية، أو إذا أجرينا استفتاء في وسط الذين يتعاملون بالربا في مسألة تغيير النظام الربوي بنظام آخر لا ربوي، أو مسألة التبرّج في وسط النساء، إذا سئلن عن رأيهن في إلغاء التبرّج… فالواقع يشهد أنّه في العالم الإسلامي حيثما استفتينا الناس فإن أغلبية الناس ستكون مع الإسلام بالجملة أو بالتفصيل. ويزداد هذا الأمر يقينية في الأحكام المعروفة والمشهورة والمنصوصة من الدين، ومن قال غير هذا فنحن نرفع التحدّي على صعيد العالم الإسلامي كله.
ثانياً: لنفترض جدلاً، من باب ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65] ونقول: لو أن أغلبية شعب أو قطر إسلامي رفضت شيئاً من الإسلام أو أقرت شيئاً يخالف الإسلام. هذا الأمر -في الحقيقة- في غاية الأهمية؛ لأنه سيفتح أعيننا – لو وقع – على الحقيقة المرة التي يجب أن نعرفها ونعالجها؛ لأن الإسلام قبل أن يكون دولة ونفوذاً وسلطة، قبل ذلك هو قناعة واختيار وتعبّد وتديّن، فإذا افترضنا أنّه في قطر من الأقطار الإسلامية بلغ الإبعاد والابتعاد عن الدين، والجهل بمقتضياته وضعف التدين وتفشي التروع اللاديني إلى درجة أن يرفض الناس الشريعة جملة أو أن يرفضوا شيئاً من أحكامها، فهذا في الحقيقة اكتشاف خطير؛ وفائدة الديمقراطية في هذه الحالة هي أنها عرفتنا على حقيقة الأمور، حتى لا نبقى – نحن المؤمنين بهذه الأحكام- من المخدوعين الغافلين، ونعرف إلى أية درجة انحط التدين وانحسر، وهذه هي الفرصة الوحيدة للعلاج، إذ كيف لنا أن نعالج واقعاً لا نعرفه، فيهمنا أن نطرح هذا التحدي كي نستفيد منه، ونكون مسرورين ليس بوجود هذه الحقيقية، بل باكتشافها، أي بمعرفة الواقع المر كما هو والقيام لمعالجته.
ثم يجب أن نعرف أن الرسول صلّى اللهُ عليه وسلّم حين طبّق الإسلام في مجتمع المدينة، التطبيق التشريعي الكامل، كانت المدينة قد أصبحت في عمومها وفي أغلبيّتها على عقيدة الإسلام وتحت سلطة الإسلام، السلطة المعنوية والقلبية والروحية، وأما قبل ذلك فلم يطبّق الرسول صلّى اللهُ عليه وسلّم الإسلام تطبيقاً عامّاً ملزماً، فلم يحاول أن يطبّقه على أهل مكة ولا غيرهم. ولقد عاش المسلمون في الحبشة ولم يطالبوا النجاشي بأن يطبق الإسلام ويحكم بالإسلام بالرغم من أنه أسلم، وكان في إسلامه نوع من الخفاء، ولم يعلنه صراحة إلا الرسول صلّى اللهُ عليه وسلّم بعد أن مات النجاشي. ويمكن أن يقال: إن رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم لم يطبق الإسلام في مكة؛ لأنه لم تكن له القدرة المادية. لكن النجاشي كان صاحب سلطة، ولكن أغلبية الناس ليسوا على الإسلام، فكيف يطبقه عليهم وهم لا يؤمنون به. وأي شيء أفسد للإسلام وأكثر تشويهاً له من أن يلزم ناس بتطبيقه وهم لا يؤمنون به ولا يرتضونه؟. فإذا افترضنا أن مجتمعاً إسلامياً اختار غير الإسلام شريعة أو اختار من الإسلام أموراً ورفض أموراً أخرى، فإن العمل حينئذ ليس هو إلزام الناس وإكراههم وتطبيق هذا الإسلام الذي تفلتوا منه، بل الحل هو إقناع الناس وإعادتهم إلى رشدهم ودفعهم إلى تصحيح علمهم ومعرفتهم بالإسلام، وبعد ذلك نأتي إلى التطبيق، فلا نتصوّر أنه من الصواب تطبيق الإسلام على قوم أغلبيتهم يرفضونه أو يرفضون شيئاً منه. وهذا الافتراض يكون أقرب إلى المعقولية في الرفض الجزئي. ويمكن أن يتصوّر في أمور من الدين الناس فيها متعرّضون للتضليل والتجهيل. فخير لنا حينئذ أن نعرف هذه الحقائق ثم نصلحها، من أن نتمادى في المطالبة بتطبيق شيء على ناس يرفضونه وابتعدوا عنه ونفروا منه لسبب من الأسباب.
وبغض النظر عن هذا الإشكال الافتراضي، فالعالم الإسلامي الذي شعوبه مسلمة بنسبة كبيرة جداً أو بنسبة كاملة، يستحيل عملياً إذا أعطيت الحرية الحقيقية للناس وللممثلين الحقيقيين للناس أن يختاروا أو يبتغوا غير الإسلام ديناً وشريعة، ولن يكون هذا إلا أقرب طريق وأيسر طريق إلى تطبيق الإسلام وإقامته.