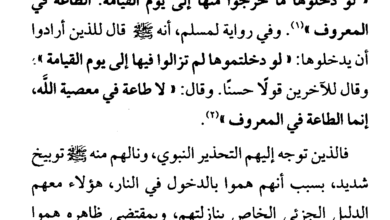التقريب لمقاصد الشريعة

التقريب لمقاصد الشريعة
أحمد الريسوني
- حول فكرة التقريب
كثيرا ما أتلقى أسئلة من هذا القبيل:
* هل المقاصد تصلح لعامة
الناس ويصلحون لها؟ أم أنها خاصة بالعلماء؟
* هل عامة الناس يفهمون المقاصد أم أنها فوق عقولهم؟
* هل العامة يستفيدون فعلا من المقاصد؟ أم أنها مجرد فتنة لهم في دينهم
وتدينهم؟
* وسألني مرة مقدِّمُ برنامج تلفزيوني – وكنا في حلقة عن مقاصد الشريعة
-: هل يمكن أن نُعَلم مقاصدَ الشريعة لأبنائنا في المدارس؟
* ومنذ نحو عشرين سنة كنت
أتذاكر مع أستاذ من كلية الشريعة بدمشق، وتطرقنا إلى تدريس مادة مقاصد الشريعة
بالمغرب… فسألته: وهل تدرَّس في كليتكم مادة مقاصد الشريعة؟ فقال لي ما معناه:
لقد تدارس أساتذة الكلية هذا الموضوع، وانتهوا إلى أن هذه المادة لا تصلح لطلبة
الباكلوريوس (الإجازة)، لأن مستواهم لا يتحملها، ولأنها ستُجَرِّئُهم على الشريعة
وتدفعهم إلى التفلسف والانزلاق في فهم أحكامها. لكنهم قرروا إمكانية تدريسها في
الدراسات العليا، وما زال الأمر قيد الدراسة قبل تطبيقه…
* وتلقيت مرارا من بعض الأساتذة والطلبة الشرعيين تحفظا مفاده: أن
ترويج المقاصد يتيح لكثير من الناس سوء استعمالها وتعطيلَ الأحكام الشرعية من خلالها.
فلذلك رأيت أن أخصص هذه الحلقة الأولى من حلقات (التقريب لمقاصد
الشريعة) للإجابة عن هذه التساؤلات، إجابةً مركبة ومركزة.
فأولا: مقاصد الشريعة ليست بالصعوبة التي يتصورها البعض، ويجعلونها
بسبب ذلك مستعصية عن إدراك عامة الناس وفوق عقولهم. بل أكاد أقول: إن معرفة
المقاصد هي الأسهل – أو الأقل صعوبة – ضمن بقية العلوم الإسلامية؛ فهي أسهل من
الفقه، ومن أصول الفقه، ومن علم مصطلح الحديث. وهي أسهل بكثير من علوم اللغة
العربية، وخاصة علمَ النحو الذي تعلمناه ونحن في المرحلة الابتدائية.
طبعا أنا لا أتحدث عن استنباط المقاصد وتقريرها وإثباتها من خلال
أدلتها ومسالكها، فذلك – لا شك – شأنُ العلماء المتخصصين المتمكنين، كما هو الحال
– مثلا – في استنباط النحو وقواعده من كلام العرب. وقل هذا في سائر العلوم. وإنما
الحديث عن تلقي المقاصد وفهمها كما هي مقررة ومحررة عند العلماء.
ومع التسليم بأن الاستنباط عموما، واستنباطَ مقاصدِ الشريعة خصوصا،
هو من اختصاص العلماء المؤهلين، فإن مما ينبغي التنبيه عليه أن فهم مقاصد الشريعة
وأخذها مباشرة من نصوصها وأحكامِها ليس دائما متوقفا على العلماء واجتهادهم
واستنباطهم، بل هناك مقاصدُ وحِكَمٌ لا تكاد تخفى على أحد، ومنها ما لا يحتاج إلا
لقليل من الاهتمام والانتباه. فهي في ذلك شبيهة بهذه التمار المتنوعة التي أنعم
الله بها على عباده، من فواكهَ وخضرٍ وحبوب؛ فإن منها ما هو ظاهر قريب، قطوفه
دانية، ومنها ما يحتاج إلى حفر وتنقيب لاستخراجه من باطن الأرض، ومنها ما هو عالٍ
فوق نخل وأشجار مرتفعة بعيدة المنال، ويحتاج إلى وسائل للوصول إليه وجنيه…
ثانيا: أحكام الشريعة ومقاصدُها ليست من قبيل علم الباطن «المضنون به
على غير أهله»1، وليست من العلوم العقلية المعقدة كما هو شأن المنطق والفلسفة
ونحوِهما من علوم الخواص، وليست من قبيل علم الكلام الذي يستدعي «إلجام العوام»2.
بل هي تهم جميع المكلفين، ويستفيد منها جميع المكلفين، كلٌّ بقدْره. ولذلك فهي لا
بد أن تكون قابلة للإفهام والتقريب إلى الأفهام، حتى ما كان منها في الأصل عميقَ
الغور بعيدَ المنزع.
– فأحكام الشريعة ومقاصدُها يمكن دراستها وتدريسها بأعلى المستويات،
وهو مستوى المتخصصين، بِلغتهم ومصطلحاتهم وتدقيقاتهم ونقاشاتهم.
- ويمكن عرضها بمستوى متوسط،
وهو المستوى المناسب لعامة المتعلمين والمثقفين والطلبة الجامعيين.
– ويمكن عرضها حتى بمستوى أدنى من ذلك وأيسر، وهو مستوى عامة الناس، ومستوى اليافعين من فتيان وفتيات. وعلى هذا الأساس نفهم العبارة الشهيرة للإمام الشاطبي: «هذه الشريعة المباركة أمية…». أي أنها في متناول فهم الأميين، فضلا عمن فوقهم، وإن كانت الأفهام في ذلك متفاوتة غير متساوية.
والمسألة – في مستوياتها الثلاثة – يمكن تشبيهها بالسباحة في البحر، والسباحة في النهر، والسباحة في مسبح أو حوض. المهم أن السباحة يمكن أن تكون متاحة للجميع وفي متناول الجميع. فهكذا الشريعة ومقاصدها. وإذا وجدتَ شيئا لا يفهمه أحد من المكلفين، بأي درجة، فاعلم أنه ليس من الشريعة ولا من مقتضياتها.
ثم نحن قد تلقينا دروسا فقهية في مرحلة متقدمة من أعمارنا وتعليمنا،
فتلقينا: فرائض الوضوء، ومستحباته، ومكروهاته، ومبطلاته… وتلقينا مثل ذلك وأكثر
في بقية الأركان والأبواب الفقهية، كالصلاة والصيام والحج والإرث… فأين ذلك – في
صعوبة فهمه وحفظه – من يسر الحديث ووضوحه، إذا ما تحدثنا عن مقاصد الطهارة والصلاة
والصوم والحج والمعاملات؟
وقد حدثني بعض الأصدقاء المصريين عن عالم مصري كان يلقي دروسه في
المسجد، وكان لا ينفك كلامه عن ذكر مقاصد الشريعة وحِكَمها، ومع ذلك لم ينفَضَّ
الناسُ عنه، بل كان الإقبال عليه والتجاوب مع دروسه منقطع النظير.
ثالثا: القول بأن ترويج مقاصد الشريعة يتيح لبعض الناس سوء
استعمالها، وتعطيلَ نصوص الشريعة من خلالها، هو قول صحيح، لكن الحل ليس في اجتناب
المقاصد وطمسها، بل الحل هو نشر الثقافة المقاصدية الصحيحة، وبث الوعي المقاصدي
القويم، وترسيخ الاستعمال السليم للمقاصد، كما أصَّلَه وسار عليه الأئمةُ والعلماء
الراسخون. هذا مع العلم أن سوء الفهم وسوء الاستعمال – سواء عن قصد أو عن جهل –
ليس خاصا بالمقاصد، بل يَرِدُ ويقع في كل العلوم. وحتى القرآن العظيم، الذي لا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كثيرا ما يساء تفسيره ويساء استعماله، فهل
نمنع التفسير؟ أم نمنع من تدبر القرآن؟ أم نمنع قراءته على «العوام» حتى ننهي
المشكل من أصله؟!
وأما قول العلامة محمد الطاهر بن عاشور: «وليس كل مكلف بحاجة إلى
معرفة مقاصد الشريعة، لأن معرفة مقاصد الشريعة نوع دقيق من أنواع العلم، فحقُّ
العاميِّ أن يتلقى الشريعة بدون معرفة المقصد، لأنه لا يُحسن ضبطه ولا تنزيله، ثم
يتوسع للناس في تعريفهم المقاصدَ بمقدار ازدياد حظهم من العلوم الشرعية، لئلا
يضعوا ما يلقنون من المقاصد في غير موضعه، فيعود بعكس المراد»1، ففيه ما هو مسلَّم
كالتدرج والتوسع في تلقين المقاصد وبيانها بحسب مستوى المخاطبين بذلك. ومنه ما
تقدم الجواب عنه، كتنزيل المقاصد في غير مواضعها..، ومنه ما ستأتي مناقشته بحول
الله تعالى في الحلقة القادمة المخصصة لتعريف المقاصد وبيان فوائدها…
- التعريف بمقاصدالشريعة
مصطلح (مقاصد الشريعة) يراد به في الاستعمال الجاري: الحِكَمُ
والغايات التي وُضعت الشريعةُ وأحكامُها وتكاليفُها لأجل تحقيقها وتحصيل فوائدها.
ولذلك عرفها العلامة الأستاذ علال الفاسي بقوله: (المراد بمقاصد
الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها). (مقاصد
الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص3)
ويستعمل العلماء في التعبير عن مقاصد الشريعة وتعريفها مصطلحات أخرى،
هي بمثابة شرح وتوضيح لمقاصد الشريعة. فمنها: حِكَمُ الشريعة، وعِلَلُ الشريعة،
وأغراض الشريعة، وأسرار الشريعة. ومن المعاصرين من يعبر عنها بفلسفة الشريعة، أو
فلسفة التشريع الإسلامي.
ومعلوم أن مقاصد الشريعة وأغراضها وفوائدَها إنما هي منفعة العباد
ومصلحتهم وسعادتهم، في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى مستغنٍ تمام
الاستغناء عن الشريعة ومقاصدها، وعن العباد وعباداتهم وسائرِ وأعمالهم. فهو الخالق
لكل شيئ والقادر على كل شيء }لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ
اللَّهَ هوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ{ (لقمان: 26).
فالتكليف الشرعي وما في ضمنه من أحكام، لا يخلو: إما أن يكون مقصوده
عائدا إلى الله تعالى (أي المكلِّف)، أو عائدا إلى العباد (أي المكلَّفين). أو
بعبارة أخرى: وضْعُ الشريعة وتكليفُ العباد باتباعها، هل هو لمصلحة الخالق، أو
لمصلحة الخلق؟
قال الفخر الرازي: «والأول باطل بإجماع المسلمين فتعين الثاني، وهو
أنه تعالى إنما شرع الأحكام لأمر عائد إلى العبد. والعائدُ إلى العبد إما أن يكون
مصلحةَ العبد، أو مفسدتَه، أو ما لا يكون مصلحته، ولا مفسدته. والقسم الثاني
والثالث باطلان باتفاق العقلاء، فتعين الأول. فثبت أنه تعالى إنما شرع الأحكام
لمصالح العباد». (المحصول من علم الأصول 5 / 172)
وهكذا أطبقت كلمة العلماء المعتبرين في الأمة على أن الشريعة إنما
جاءت لأمرين هما: جلب المصالح للعباد، ودرء المفاسد عنهم، في دنياهم وآخرتهم. وقد
يعبر العلماء عن جلب المصالح ودرء المفاسد بالتحصيل والإبقاء، أو بالنفع والدفع، أو
بالاجتلاب والاجتناب.
ويدخل في جلب المصالح: إيجاد ما هو مفقود، وتنمية ما هو موجود. أما
درء المفاسد فيدخل فيه إزالتها وتقليلها والوقاية منها.
ومن عباراتهم في هذا الباب: الرسل بعثت لجلب المصالح وتكميلها، ودرء
المفاسد وتقليلها.
وقد بين ذلك العلامةُ ابنُ قيم الجوزية بقوله: «فإن الشريعة مبناها
وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها، ورحمة كلها،
ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجَور، وعن الرحمة إلى
ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت
فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه،
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم…». (أعلام الموقعين عن رب
العالمين 3 / 3).
وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي: «وضْعُ الشرائعِ إنما هو
لمصالح العباد في العاجل والآجل معا».
وإذا كانت هذه هي مقاصد الشريعة في أصلها وعمومها ومجملها، فإن ذلك
ينبغي أن يكون جاريا ومتحققا ومطَّردا في كل باب من أبوابها التشريعية، وفي كل
حُكْمٍ من أحكامها الجزئية.
وبناء عليه، فإن (مقاصد الشريعة) التي نتحدث عنها، يمكن النظر فيها
وتصنيفها من خلال ثلاث دوائر بيانها فيما يلي.
- الدوائر الثلاث لمقاصدالشريعة
- دائرة المقاصد الكلية العامة.
- دائرة المقاصد الخاصة (أو الوسطى)
3- دائرة المقاصد الجزئية.
وفيما يلي تعريف وتوضيح لهذه الدوائر الثلاث:
➀الدائرة الأولى:هي دائرة المقاصد الكلية لعموم الشريعة
ومجمل المقاصد العامة للشريعة لا يخرج عما ذكر من قبل، وهو: جلب
المصالح: الفرديةِ والجماعية، المادية والمعنوية، الحالية والمآلية، الظاهرة
والخفية، الدنيوية والأخروية. ومعلوم أن جلب المصالح يستدعي درء المفاسد التي
تعارضها أو تؤدي إلى الإضرار بها. ولذلك فكل مصلحة تُجلب، توجد في مقابِلِها مفسدة
أو مفاسد تُدفع. فهذه هي مقاصد الشريعة في مجملها.
ثم تندج في هذه الدائرة العامةِ مقاصدُ كلية كبرى، من أبرزها
الضرورياتُ الخمس، التي سأعود لاحقا لبيانها؛ وهي: الدين والنفس والنسل والعقل
والمال. وإنما اعتُبِرت هذه الضروريات الخمسُ مقاصدَ كليةً، لأن غيرها من المقاصد
والمصالح الشرعية مندرج فيها، أو متفرع عنها، أو خادم لها. ثم تأتي بعدها مقاصد
عامة أخرى، كإقامة العدل، وعمارة الأرض، وحفظ الأمن والوئام، وتزكية النفوس،
وإخراج المكلفين من سلطان الهوى إلى سلطان الشرع والعقل.
ومقاصد الشريعة في هذه الدائرة هي المسماة: (المقاصد العامة). وهي
المقاصد التي ثبتت رعايتها في كل أبواب الشريعة، أو في معظمها.
➁الدائرة الثانية:هي دائرة (المقاصد الخاصة)
والمراد بالمقاصد الخاصةِ المقاصدُ المرعيةُ في مجال معين من
المجالات التشريعية، فتكون الأحكامُ الشرعية في هذا المجال مبنيةً على مراعاة تلك
المقاصد وحائمةً حول تحقيقها وخدمتها، كأنْ نقول مثلا: مقاصد العبادات هي تعظيم
الخالق سبحانه، والارتباط الدائم بين العبد وربه، وتزكيةُ النفوس وتغذية القلوب…
فأحكام العبادات أساسها ومناطها تحقيق هذه المقاصد.
وعلى هذا النحو يمكن الحديث عن: مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة،
ومقاصد الشريعة في المعاملات المالية، ومقاصد الشريعة في مجال التبرعات، ومقاصد
الشريعة في مجال العقوبات، ومقاصد الشريعة في مجال الولايات العامة، ومقاصد الشريعة
في أحكام العادات والآداب الاجتماعية… (انظر القسم الثالث من كتاب (مقاصد
الشريعة الإسلامية) لمحمد الطاهر بن عاشور.
وقد نضيق الدائرة، فنتحدث عن مقاصد الصلاة، ومقاصد الزكاة، ومقاصد
الزواج، ومقاصد الجهاد، ومقاصد أحكام المواريث…
➂الدائرة الثالثة:هي دائرة (المقاصد الجزئية)
وهي المقاصد الخاصة بكل حكم من أحكام الشريعة، على حدته. فمقاصد
الأحكام الجزئية منفردة، هي أيضا مما يدخل في مسمى (مقاصد الشريعة)، بل هي الأساس
الأول الذي من خلاله وبواسطة الاستقراء والربط نتوصل إلى معرفة المقاصد العامة
والمقاصد الخاصة.
والحكم الشرعي الواحد قد يكون له مقصد واحد، كالأمر بالإشهاد في
العقود وبعض المعاملات، مقصوده التوثيق المانع من التجاحد والتنازع، وكالحث على
نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها، ومثله نظر المخطوبة إلى خاطبها، مقصوده حصول الميل
والرغبة والقبول، قبل الإقدام على الزواج.
وقد يكون للحكم أكثرُ من مقصد، كعِدَّة المرأة المطلقة؛ يُقصد بها
التثبت من الحمل أو عدمِه، وتأمينُ السكنى والنفقة للمطلقة طيلة فترة عدتها،
ويُقصد بها أيضا كبحُ الأزواج عن استسهال الطلاق والتسرع في حسمه وإنفاذه. وأيضا:
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فتكون مدة العدة فرصة للمراجعة والتراجع والتصالح بين
الزوجين.
وكالأذان شرع لدعوة المصلين إلى صلاة الجماعة، وللإعلام بدخول الوقت، ولذلك يسمى نداء، ويسمى أذانا.
وكتحريم المسكرات: له مقاصد عديدة، منها: حفظ العقول، وحفظ الأبدان،
وحفظ الأموال، وحفظ أداء العبادات والواجبات، وتلافي فساد العلاقات والمعاملات.
فكل هذه المقاصد وأمثالها هي مقاصد جزئية.
ويتلخص عندنا مما سبق أن الحديث عن مقاصد الشريعة يقع على ثلاثة
مستويات : المقاصد العامة، والمقاصد الخاصة، والمقاصد الجزئية.
ومعلوم أن المقاصد الجزئية تندرج حتما في دائرة المقاصد الخاصة. وهما معا (أي الجزئية والخاصة) مندرجان في دائرة المقاصد العامة. فالمقاصد الخاصة تتشكل من المقاصد الجزئية، والمقاصد العامة تتشكل من المقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية معا.
- فوائد المقاصد
معرفة مقاصد الشريعة لها من الفوائد العلمية والعملية الشيء الكثير.
وهذه الحلقة أخصصها للفوائد العلمية، مقتصرا على أهمها، فيما يلي:
- الوقوف على حكمة الله جل جلاله:
وحكمة الله في شرعه هي أختُ حكمةِ الله في صنعه.
فكما أن لله تعالى آياتٍ في خلقه وصُنعه، فكذلك له آياتٌ في حكمه وشرعه، }أَلَا
لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ{ (الأعراف : 54).
فالبحث والنظر في أسرار الشريعة ومقاصدها شأنه كشأن البحث والنظر في
أسرار الطبيعة وفوائدها. فكل منهما يزيدنا معرفة بالله وصفاته، ويزيدنا طمأنينة
إلى لطفه وبالغ حكمته. وهذا هو منهج سيدنا إبراهيم الذي قال }رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ
تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ
قَلْبِي{ (البقرة: 260). فنحن على ملة إبراهيم ونهجه، عليه الصلاة والسلام.
- زيادة التفقه والعلم بأحكام الشرع:
ومعلوم أن معرفة مقاصد الشريعة والتأمل فيها
وتحصيل مكنوناتها، يعطي درجة عالية من الفقه وسداد الفهم عن الله. ولا يستقيم دين
ولا تدين إلا بالعلم والفهم والفقه.
وفي صحيح الإمام البخاري: «باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله
تعالى: }فاعلم أنه لا إله إلا الله{، فبدأ بالعلم. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء،
ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا
إلى الجنة. وقال جل ذكره: }إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء{. وقال: }وما يعقلها
إلا العالمون{، {وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير{. وقال: }هل
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون{. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد
الله به خيرا يفهمه».
وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام (في سورة الكهف) ما يفيد أن درجة
الرشد والكمال في الدين إنما تحصل بفهم أسرار الأحكام ومقاصدها. وقد كان الخضرُ
أعلمَ وأمْكَنَ من موسى في هذا الباب؛ فموسى أوتي معرفة الأحكام، والخضر زاد عليه
بمعرفة الحِكَم. ولذلك سأل موسى الخضرَ أن يعلمه ويزيده تبصرا ورشدا. قال تعالى:
}فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا
آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ
لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا{
(الكهف: 64 – 66). فالرشد والعلم هنا إنما يتعلقان بمعرفة المقاصد والحِكَم، كما
ظهر ذلك جليا في الدروس الثلاثة التي قدمها الخضر لموسى…
- دفع الشبهات وتوضيح الإشكالات:
هناك كثير من أحكام الشرع لا يكون مقصودها ظاهرا
واضحا ولا تفهم حكمتها بتلقائية. فلذلك قد تَستشكل العقولُ تلك الأحكامَ وتتحير في
مغزاها ومرماها. وهذا هو الذي حصل لموسى إزاء تصرفات الخضر، في خرقه للسفينة،
وقتله للغلام، وإقامته لجدار القرية
…
فالمؤمن إذا عرض له شيء من هذا وشغل عقله، فسبيله الأمثل الأفضل هو
أن يبحث ويتدبر ويسأل ويحاور أهل العلم… فإن لم يكن قادرا على هذا، فسبيله أن
يقول: }آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا{ (آل عمران: 7).
وقد تكون الشبهات مصطنعة ومثارة عن عمد وقصد، بُغْية الطعن على
الشريعة والتشويش على أهلها. فهنا أيضا لا ينفع إلا التسلح بمعرفة المقاصد لدفع
تلك الشبهات والمطاعن. قال الإمام شهاب الدين القرافي: «وأما القيام بدفع شُبَهِ
المبطلين، فلا يَتعرض له إلا من طالع علوم الشريعة وحفظ الكثير منها، وفهم مقاصدها
وأحكامها، وأخذ ذلك عن أئمةٍ فاوَضَهُم فيها، وراجعهم في ألفاظها وأغراضها»
(الذخيرة 13/ 232).
- الفوائد العملية للمقاصد
تناولتُ في الفقرة السابقة بعض الفوائد العلمية لمعرفة المقاصد،
وأُتبِعها ببعض الفوائد العملية.
1. الإقبال على التنفيذ والتحصيل
قديما قالوا: «من عَرف ما قَصد، هان عليه ما وجد». ويقال: «من عرف ما
قصد، هان عليه ما ترك». وقيل أيضا: «من عَرف ما يَطلب، هان عليه ما يَبذل».
ومعنى هذا أن المكلف بفعل شيء أو بتركه، إذا قام بالفعل أو بالترك
وهو يعلم الغرض المقصود والهدف المنشود من ذلك الفعل أو الترك، فإنه ينشرح له
ويتحمس لتنفيذه، ولا يبالي وقد لا يحس بما فيه من مشقة وعناء، بخلاف من كُلف بفعل
شيئ أو بتركه، وهو لا يدرك له مغزى، ولا يرى لذلك فائدة، وإنما يفعله فقط لأنه
ملزم بفعله ومحاسب عليه، فهذا قلما يُقْدم على الامتثال والتنفيذ إلا بتثاقل
وتبرم، مع بقائه عرضة للتعثر والانقطاع فيما كلف به.
فمثلا: من لا يدري من مقاصد الزكاة شيئا، يكون أقرب إلى الشح بها
والتهرب من أدائها والاحتيال لإسقاطها. وعلى ضده تماما مَن عرف قيمة الزكاة
وفوائدها له ولغيره. ومن لا يعرف مقاصد تحريم الزنا قد يجد معاناة شديدة في
اجتنابه، لأنه يراه مجرد حرمان وتضييق. لكن من عرف ما وراء ذلك التحريم من مصالح
تُرتجى ومفاسد تُتقى، هان عليه اجتنابه والإعراض عنه.
2. تسديد العمل
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: «قصْدُ الشارعِ من المكلف: أن يكون
قصدُه فى العمل موافقا لقصده فى التشريع» (الموافقات2/331). بمعنى أن المكلف حين
يعمل بأحكام الشرع، يجب أن يجعل مقصودَه في عمله مطابقا ومحققا لما قصده الشارع في
حكمه. وهذا يقتضي أن يعرف المكلفُ – ما أمكنه – مقاصد الشرع في أحكامه وتكاليفه،
لكي يتمكن من مراعاتها وموافقتها. وأما إذا لم يعرفها، فكيف له أن يوافقها
ويحققها؟ بل قد يؤدي العمل ويحقق به عكس ما قصده الشارع. فالذي يصوم وهو لا يعرف
ولا يراعي شيئا من مقاصد الصوم، يمكن أن يكون صومه وبالا عليه وعلى غيره. ولذلك
جاء في الحديث الشريف:(كم مِن صائم ليس له من صيامه الا الجوع، وكم مِن قائم ليس
له من قيامه الا السهر). فالذي يصوم بالنهار ويضاعف أكله وشربه بالليل، والذي يصوم
عن الأكل والشرب، ولكنه يظل يتكلم بالحرام ويسمع الحرام ويشاهد الحرام،
والذي يصوم وهو متوتر ضَجِر بصومه، فيغضب على الناس ويؤذيهم بعبوسه
وخشونته وسوء أدبه… هؤلاء لم ينتفعوا بصومهم ولا نفعوا به غيرهم.
3. تحديد الوسائل وحسنُ استعمالها
من المعلوم أن الوسائل تابعة لمقاصدها؛ فالوسيلة ونوعها ومقدارها
وطريقة استعمالها… كل ذلك إنما يتضح ويتحدد، بناء على معرفة الغرض المقصود.
والشرع قد عين كثيرا من الوسائل لتحقيق مقاصده: كالإخبار بدخول أوقات
الصلوات بواسطة الأذان. وكحفظ النسل بواسطة مشروعية الزواج وتحريم الزنى والشذوذ
الجنسي.
على أن الوسائل المنصوصة في الشرع إذا لم تكن من جملة العبادات، فهي
ليست على سبيل الحصر والتوقيف واللزوم، وإنما هي قابلة للتنويع والتغيير والزيادة
بحسب الحاجة. فمثلا: من مقاصد الشريعة إقامة العدل. وقد نصت الشريعة على كثير من
الأحكام التي هي وسائل لتحقيق العدل. ولكن إذا علمنا أن العدل مطلوب شرعا في جميع
المجالات والظروف والأحوال، فهذا يقتضي تنويع وسائله وتكثيرها وتطويرها، بما يسع
ويلائم كافة المجالات والظروف والأحوال.
والمقصود الآن هو أن تحديد الوسائل وتكييفها وإعدادها وحسن
استعمالها، لا بد فيه من معرفة المقاصد أولا.
- تعريف المصلحة والمفسدة
مقاصد الشريعة كما تقدم مدارها على قضية واحدة: «جلب المصالح ودرء
المفاسد”.
فما هي حقيقة المصلحة؟ وما هي حقيقة المفسدة؟
من أشهر تعاريف المصلحة عند الأصوليين وعند الفلاسفة قبلهم هذا التعريف الذي أورده الفخر الرازي في كتابه (المحصول)، وقال فيه: «المصلحة لا معنى لها إلا اللذةُ أو ما يكون وسيلة إليها، والمفسدة لا معنى لها إلا الألم وما يكون وسيلة إليه”
ويرى البعض أن هذا التعريف عليه بعض التحفظات أو الإعتراضات، أهمها:
كون اللذة في الاستعمال الشائع يراد بها اللذات الجسدية، كالأكل
والشرب والنوم والجماع واللمس والنظر… فهل المصلحة مجرد لذة جسدية؟
كون اللذة يدخل فيها كثير من اللذات المحرمة، فهل هذه أيضا مصلحة؟
تعريف المفسدة بالألم، يعارضه أن بعض الأمور المؤلمة قد تكون مشروعة
أو واجبة، كالصوم والجهاد ومتاعب الحج؟!
والحقيقة أن هذه التحفظات والاعتراضات كلها ناشئة عن المفاهيم العامية الشائعة لمفردات هذا التعريف، وتصحيح ذلك فيما يلي:
فأولا: اللذة المقصودة في الشرع ليست مقتصرة على اللذة الجسدية، بل
اللذة تشمل إلى ذلك كل ما يخطر على البال وما لا يخطر مما يتضمن أو يجلب سعادة
الإنسان وطمأنينته، من اللذات المعروفة والممكنة؛ بما في ذلك لذة الإيمان واليقين،
ولذة العبادة والذكر، ولذة العلم والمعرفة، ولذة فعل الخير والإحسان، ولذة الأمن
والسلامة، ولذة العواطف والمشاعر النبيلة التي تجمع بين قلوب الناس، ولذة الجنة
التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وكذلك لذة الاستمتاع بما في الكون
والحياة من مظاهر الحسن والجمال والبهجة. وأعلى اللذات وأسماها لذة لقاء الله
والظفر برضاه والنظر إلى وجهه الكريم، على النحو اللائق بالمقام.
وثانيا: ما قيل عن تعريف المصلحة باللذة يقال مثله في تعريف المفسدة
بالألم. فالألم ليس مقصورا على أوجاع الجسد، كالمرض وآلامه، وكآلام الجوع والعطش،
والتعذيب والضرب والحرمان من الشهوات والضرورات. ليس هذا وحده هو الألم، بل
المعاناة والغموم والاضطرابات القلبية والنفسية كلها آلام، وكلها داخلة معنى
المفسدة. فالفراغ الروحي الناشئ عن الكفر أو عن فقدان الإيمان والصلةِ بالله عذاب
ومفسدة. والشعور بالضياع وعبثية الحياة ألم ومفسدة. وفي التعرض للمهانة والإذلال
والظلم آلام ومفاسد، وتفكك الأسرة وفقدان دفئها وأنسها وتكافلها فيه ما لا يحصى من
المفاسد والآلام. وكذلك فساد الأخلاق والعلاقات بين الناس. والنار يوم القيامة هي
أكبر مفسدة وألم ينتظر مستحقيه ، والسعي إليها هو سعي إلى المفسدة وإلى الألم. وكل
وسيلة تجر إليها فهي مفسدة كذلك.
وللتنبيه على هذه المعاني جاء عز الدين ابن عبد السلام إلى التعريف
السابق فأضفى عليه بعض الإضافات والتوضيحات التي تجعله أتم وأسلم من الاعتراض.
فقال في كتابه (قواعد الأحكام):
«المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها.
والمفاسد أربعه أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها.
وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية».
وأما الإمام أبو حامد الغزالي فقد نحا في تعريفه المختار للمصلحة
الشرعية منحى مختصرا ومباشرا فقال في كتابه (المستصفى): «… نعني بالمصلحة
المحافظةَ على مقصود الشرع؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل
ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة».
ومن خلال التطرق في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى إلى أنواع
المصالح والمفاسد ومراتبها ووسائلها وأمثلتها… سيتضح مضمونها ومفهومها أكثر
فأكثر.
- المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة
لقد تقرر وتكرر أن الشريعة مصلحة كلها وحكمة كلها ورحمة كلها…
وأنها إنما وضعت لجلب مصالح العباد…
فهل الشرع اعتبر واعتمد كل ما يطلبه الناس ويعتبرونه مصلحة؟ أم اعتبر
بعض ذلك ولم يعتبر بعضه الآخر؟ بعبارة أخرى: ما هو موقف الشرع من هذه «المصالح»
التي تملأ الدنيا وتشغل الناس؟
من هذه الزاوية قَسَّمَ الأصوليون المصالح السائدة عند الناس إلى
ثلاثة أنواع:
1. المصالح المعتبرة،
2. المصالح الملغاة،
3. المصالح المرسلة،
– المصالح المعتبرة: هي التي نص الشرع على
اعتبارها وقبولها، أو حث على تحصيلها ورعايتها. ويأتي في مقدمة ذلك الفرائضُ
والواجبات، كالصلاة والزكاة والصوم والحج، والوفاء بالعهود وأداء الأمانات،
والصدقِ في القول والإخلاصِ في العمل…
وكل ما هو منصوص عليه من مندوبات ومباحات، فهو مصلحة معتبرة.
وكل ما مدحه الشرع أو مدح فاعله، فهو كذلك مصلحة معتبرة.
فقوله عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم»،
فيه أمر ومدح، فهو يدل على مشروعية الزواج وأنه مصلحة معتبرة مأمور بها، وفيه مدح
يدل على اعتبار مصلحة التناسل وتكثير عدد المسلمين.
وكذلك ما نص الشرع على حِلِّيته فهو داخل في المصالح المعتبرة. كما
في قوله تعالى:}وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ{ فهو دال على أن البيع والشراء (أي
التجارة)مصلحة معتبرة.
وكل ما هو طيب في ذاته ومكسبه من المطعومات والمشروبات وغيرها،
فتمَلُّكُه واستعماله مصلحة معتبرة، لأن الله تعالى يقول }يَسْأَلُونَكَ مَاذَا
أُحِلَّ لَهمْ قلْ أُحِلَّ لَكمُ الطَّيِّبَاتُ..{ سورة المائدة: 4، إلى قوله
}الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ..{ المائدة: 5.
– وأما المصالح الملغاة: فهي التي نص الشرع على
أنها غير مقبولة وغير مشروعة وغير جائزة، أي أنه ألغاها وأبطل مشروعيتها. فمن هنا
جاء هذا الإسم «المصلحة الملغاة». فكل شيء وكل فعل، حرمه الشرع وسلب عنه صفة
المشروعية، فهو وما ينجم عنه يعد مصلحة ملغاة. أي أن المصالح الملغاة هي المحرمات وما
قد يكون فيها من فوائد ومنافع.
فالخمر والميسر مثلا، ذَكر الله تعالى أن فيهما منافعَ للناس، ومع
ذلك حرمهما، فصار كل منهما إذاً مصلحة ملغاة. والرشوة تحقق مصلحة خاصة لمعطيها
وآخذها، ولكنها أيضا مصلحة ألغاها الشرع ولم يعتبرها، والتعامل الربوي فيه مصالحُ
ما، ولكنها ملغاة في حكم الشرع. والغش مصلحة لصاحبه، بما يربح به من أموال ومنافع،
ولكنها مصلحة ملغاة في حكم الشرع.
وبهذا يتضح أن «المصالح الملغاة»، هي إما مصالح جزئية خاصة، في
طياتها مفاسد كلية عامة، أو هي مصالح عابرة عاجلة، تتبعها مفاسد مستمرة آجلة، أو
هي مصالح صغيرة تنطوي على مفاسد وأضرار جسيمة كبيرة.
والنتيجة أن هذه الأنواع من المصالح الملغاة في الشرع، إنما هي في
حقيقتها ومحصلتها النهائية مفاسد لا مصالح. ومعلوم عند العلماء وعند العقلاء أن
اعتبار الشيء أو التصرف مصلحة أو مفسدة، إنما يكون بحسب الغالب من أمره. فما غلب
صلاحه ونفعه في الحال والمآل والظاهر والباطن، فهو مصلحة معتبرة. وما غلب فساده
وضرره في الحال أو المآل وفي الظاهر أو الباطن، فهو مفسدة، أو هو مصلحة ملغاة.
وهذا المعيار مأخوذ من قوله تعالى }يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا{ سورة البقرة: 219.
- المصالح المرسلة:
وهي كل مصلحة سكت الشرع
عن حكمها، أي لم ينص عليها بعينها، لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. فهي قد بقيت مرسلة؛
أي خالية عن أي حكم شرعي يقيدها.
فما حكم هذا النوع من
المصالح المسكوت عنها في الشرع؟ هل تُلحق بالمصالح المعتبرة لكونها مصالحَ،
والشرعُ لم يبطلها؟ أم تلحق بالمصالح الملغاة ما دام الشرع لم ينص على اعتبارها؟
أم أنها متروكة لاختيار الناس، وليس للشرع فيها أمر ولا نهي؟
الصواب الذي عليه إجماع
الصحابة، وعليه جماهير الفقهاء في كل العصور، هو أن كل مصلحة مرسلة، إذا كانت
مصلحة حقيقية، فموقف الشرع منها هو أنها مصلحة معتبرة ضمنيا، وإن لم تكن معتبرة
إسميا؛ بمعنى أنها معتبرة بمقتضى النصوص العامة للشريعة ومضمنة في مقاصدها العامة
كذلك. فهي معتبرة ومنصوص عليها جملة وإن لم تُذكر تسمية وتفصيلا.
ولتوضيح ذلك بأمثلته أحيل
إلى التأصيل الرائد الذي حرره الإمام الشاطبي في هذه القضية. فقد ذكر رحمه الله أن
كل مصلحة لم يَرد فيها نص، إذا كانت ملائمة لمقاصد الشارع، ومن جنس المصالح التي
اعتبرها، فهي معتبرة ومطلوبة شرعا.
وقد ذكر لها عشرة أمثلة،
مما عمل به الصحابة والفقهاء، بحيث راعوا المصلحة وبنوا عليها، وإن لم يكن فيها
بعينها نص شرعي.
من هذه الأمثلة:
1. أن الصحابة بادروا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمع القرآن الكريم في مصحف واحد موحد متفق عليه، وذلك بعد أن ظهرت بعض الاختلافات هنا وهناك في قراءة بعض الآيات والألفاظ القرآنية. قال الشاطبي: «ولم يرِدْ نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا من ذلك، ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمرُ بحفظها معلوم وإلى منعِ الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن، وقد عُلم النهيُ عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه.
2. اتفاق الصحابة على رفع عقوبة شارب الخمر إلى
ثمانين جلدة. قال الشاطبي: «وإنما مستندهم فيه الرجوعُ إلى المصالح والتمسكُ
بالاستدلال المرسل. قال العلماء: لم يكن فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
حد مقدَّر، وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزيز. ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضى
الله عنه قرره على طريق النظر بأربعين. ثم انتهى الأمر إلى عثمان رضي الله عنه
فتتابع الناس، فجَمع الصحابةَ رضى الله عنهم فاستشارهم، فقال علي رضي الله عنه: من
سكر هذى، ومن هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري»
3. قرر الخلفاء الراشدون
العمل بتضمين الصُّنَّاع (الحِرفيين) لما يضيع ويتلف بأيديهم من مواد تكلفوا
بتصنيعها لأصحابها، وذلك بغض النظر عن صدقهم أو كذبهم، وعن مدى مسؤوليتهم الفعلية
في ضياعها.
قال الشاطبي: «ووجْهُ
المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب
الأحوال. والأغلب عليهم (أي الصناع) التفريطُ وترك الحفظ. فلو لم يثبت تضمينهم مع
مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية
وذلك شاق على الخلق وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع
الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة فكانت المصلحةُ التضمين»
(انظر: الاعتصام2/117 وما
بعدها.
المصالح المرسلة.. أدلتها وحجيتها
تقدم قبل قليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وفي مقدمتهم الخلفاء
الراشدون، كانوا يحتكمون إلى المصلحة المرسلة ويعملون بمقتضاها فيما لا نص فيه.
وقد اعتبر الأصوليون ذلك من أقوى الأدلة على أن المصالح المرسلة حجة يجب العمل بها
ومراعاتها، ولو لم تكن منصوصة بأعيانها وأسمائها. فيكفي لثبوت مشروعيتها وحُجيتها
أن تكون مندرجة في المقاصد العامة للشريعة، وتخدمها ولا تناقضها.
وبالإضافة إلى إجماع الصحابة على حُجية المصالح المرسلة وعملهم بها،
فإن هذه المصالح مشمولة ومشهود لها بنصوص شرعية عامة، هي التي جعلت الصحابة يجمعون
على العمل بالمصالح. وفيما يلي بعض من تلك النصوص:
- قوله تعالى: }فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ{ سورة الزلزلة. فقد تضمنت الآية الأمر والحث على كل ما هو خير، والنهيَ والتحذير من كل ما هو شر. والواقع أنه ما من مصلحة حقيقية إلا وهي خير، وما من خير إلا وهو مصلحة. قال الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: «ويعبَّرُ عن المصالح والمفاسد بالخير والشر، والنفعِ والضر، والحسنات والسيئات؛ لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات، والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات» (قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1 / 4).
- قوله سبحانه }يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكمْ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكمْ تُفْلِحُونَ{الحج: 77. فقد أمر الله تعالى بفعل
الخير مطلقا. وكل مصلحة مرسلة فهي خير، أي فهي مطلوبة شرعا بمقتضى هذه الآية.
3. قوله عز وجل }إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ…{ النحل: 90. وهذا الأمر يشمل كل عدل وكل إحسان. ومعلوم أن كل عدل فهو مصلحة، وكل إحسان فهو مصلحة. وكل طريق توصل إلى العدل، وكل وسيلة تحقق العدل، فهي مصلحة مأمور بها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: «فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرعُ اللهِ ودينُه».- (الطرق الحكمية1/ 19 - ومن الألفاظ المستعملة في
القرآن الكريم للتعبير عن مختلف أنواع المصالح والأفعال المصلحية، التعبيرُ
بالصالحات أو بالعمل الصالح، مثل قوله جل وعلا: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} العصر : 1 – 2،
وقوله {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا}
المؤمنون : 51، وقوله {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون} النحل: 97.
فأمثال هذه الآيات تفيد أن كل شيئ صالحٍ وكلَّ عملٍ صالحٍ، فهو مطلوب في الشرع، وهو جزء من الشرع.
وعموما فإن المصالح المرسلة يدخل فيها:
1. كل مصلحة مشروعة غيرِ ممنوعة، يحتاجها الناس
وينتفعون بها، أفرادا وجماعات وشعوبا، سواء عُرفت قديما أو جدَّتْ وظهرت بعد أن لم
تكن؛ كالمصنوعات المختلفة، والمزروعات المتجددة النامية، وكتحصيل العلوم والمعارف
النافعة، والقيام بالكشوف والمؤلفات العلمية، وكاستصلاح الأراضي واستثمارها
وعمارتها.
2. كل وسيلة تؤدي إلى تحقيق مقاصد الشرع ومصالح العباد وتحفظها وتخدمها؛
كالنظم السياسية والقضائية والإدارية والأمنية، وكتأسيس الأحزاب والمنظمات
الإصلاحية والجمعيات التعاونية.
فكل هذه المصالح المرسلة مقصودة ومطلوبة شرعا، إما على سبيل الوجوب،
أو على سبيل الندب، بحسب مقدار أهميتها وآثارها. وقد تكون واجباتٍ جماعيةً كفائية،
وقد تكون واجبات فردية عينية.