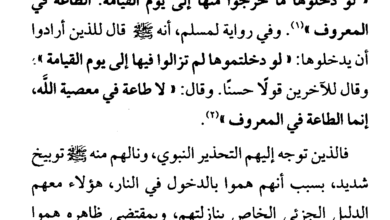مفهوم الشريعة قبل تطبيق الشريعة

أ.د أحمد الريسوني
جدل كثير وصراع مرير، يدوران اليوم في عموم الدول والمجتمعات الإسلامية ، حول قضية الشريعة وتطبيق الشريعة . والقضية في جزء منها تعود إلى ما تعيشه النخب الثقافية والسياسية من انقسام إلى تيارين كبيرين ، يتجاذبان الساحة الثقافية والسياسية ، يمكن وصفهما بالتيار الديني ، والتيار المدني(أو ما يعرف بالتيار العلماني الحداثي) . ولكن جزءا من هذا الصراع يرجع إلى الالتباس الحاصل في مفهوم الشريعة وتطبيق الشريعة.
وسواء عند المتبنين لتطبيق الشريعة المدافعين عنه ، أو عند المناوئين لهذا الهدف الخائفين منه ، فإن هناك مفاهيم وتصورات قاصرة أو مشوهة لمفهوم الشريعة ولتطبيق الشريعة . وهو ما تترتب عنه مشاكل وصراعات عدة ، يمكن تلافيها أو تقليصها بالمعرفة الصحيحة للشريعة ومضامينها.
فبسبب هذا الالتباس، نجد عددا من الناس تصوروا الشريعة وتطبيق الشريعة على طريقتهم ، فقالوا بناء على ذلك : إن الشريعة لم تطبق إلا في العهد النبوي ، ونسبيا في عهد الخلفاء الراشدين . وهذا معناه ـ في نظرهم ـ أن هذه الشريعة غير قابلة للتطبيق في هذا الزمان ،لمثاليتها ، أو لقصورها ، أو لغير ذلك من الأسباب . المهم أن تطبيقها توقف في وقت مبكر ، ولم يصمد أمام التطورات والتغيرات إلا زمنا يسيرا. فكيف يراد تطبيقها اليوم ، بعد أربعة عشر قرنا من توقف تطبيقها ؟!
وبسببه أيضا ، رأى آخرون أن الشريعة تتسم بالبدائية والتخلف والهمجية ، فكرهوها وكرهوا من يريد إحياءها ؛ فهي ـ فيما سمعوا وفهموا ـ عبارة عن قصاص وحدود ، وسيوف ودماء . فالعودة إلى الشريعة عودة إلى الوحشية والهمجية ، ونحن في زمن الحضارة والحداثة وحقوق الإنسان !
وبسبب ذلك أيضا ، ظهر لبعض المتدينين والدعاة ، أن جميع الحكومات والمجتمعات ـ الإسلامية “سابقا” ـ قد نبذت اليوم شريعة الله وعطلتها وتنكرت لها ، وقد غلا بعضهم فتحدثوا عن ردة واسعة ، قد عمت معظم البلدان الإسلامية ، شعوبا وحكومات . ومن هنا ارتفعت درجة الكراهية والغليان … وهو ما نجمت عنه إلزامات وتداعيات وردود فعل خطيرة ، ما زلنا نعيش آثارها.
لذلك ـ وقبل الحديث عن قضية الشريعة وتطبيق الشريعة اليوم ـ لا بد من الحديث عن معنى الشريعة ومفهوم السريعة.
مفهوم الشريعة من بدايته
ذكرت في حلقة سابقة ، أننا نحتاج ـ في كثير من القضايا والمفاهيم الأساسية ـ أن نرجع إلى الوراء ، وأن نرجع إلى البدايات …، فلنرجع الآن إلى البداية أيضا.
مادة ” ش ر ع ” ـ ومنها الشريعة والشرعة والشرع ـ في القرآن الكريم يشمل معناها كل ما أنزله الله لعباده ، من معتقدات ، وعبادات ، وأخلاق ، وآداب ، وأحكام عادات ومعاملات . وتأتي العقائد والعبادات في طليعة ما شرعه الله وجعله شريعة للعباد، كما هو واضح في قوله تعالى )شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ( [الشورى/13]
)أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ( [الشورى/21]
“وعن السديّ، في قوله:( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ) قال: هو الدين كله”[1]
أما لفظ “شريعة”، فقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة ، في قوله تعالى)ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ( [الجاثية/18]
وورد شقيقه ، لفظ “شرعة”، في قوله تعالى )وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا( [المائدة/48]
قال الإمام الطبري:”والشِّرْعة: الشريعة بعينها، تجمع الشِّرعة شِرَعًا، والشريعة شرائع، ولو جمعت الشرعة شرائع كان صوابا، لأن معناها ومعنى الشريعة واحد“[2].
وقال القرطبي: “والشِّرعة والشريعة: الطريقة التي يُتوصل بها إلى النجاة. والشريعة في اللغة: الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء. والشريعة ما شرع الله لعباده من الدين، وقد شرع لهم يشرع: أي سن. والشارع: الطريق الأعظم.“[3]
فالشريعة في اللغة ، تعني الطريق العظيم والصراط المسقيم.
والشريعة في استعمال القرآن مساوية لمعنى الدين ، الذي هو الصراط المستقيم .كل ما في الأمر أن استعمال”الشريعة” ، هو باعتبار واضعها وهو الله تعالى ، فهو الذي )شَرَعَ لَكُمْ …( ، وأما استعمال”الدين” فباعتبار من يدين به ، وهو الإنسان.
وبهذا المعنى الواسع الجامع للشريعة ، ألف الإمام أبو بكر الآجري ( المتوفى سنة360 هـ) كتابه الذي سماه ( الشريعة ) ، مع أن أكثر ما فيه مسائل عقدية وتربوية.
وبعده ألف المفكر الفيلسوف الراغب الإصفهاني ( المتوفى سنة 500 ، أو502 هـ) ، كتابه الشهير ( الذريعة إلى مكارم الشريعة ) ، وهو كتاب في فلسفة الأخلاق والتربية . فالراغب يعتبر ـ بحق ـ أن تهذيب النفوس والعقول والأخلاق من صميم الشريعة ومكارمها. وهو يُعرف مكارم الشريعة فيقول : “ومكارم الشريعة هي : الحكمة ، والقيام بالعدالة بين الناس ، والحلم ، والإحسان ، والفضل. والقصد منها أن تبلغ إلى جنة المأوى , وجوار رب العزة تعالى.”[4]
وقبل الوصول إلى جنة المأوى ، فإن مكارم الشريعة تتلخص في تحقيق الغايات الثلاث الكبرى للوجود الأنساني ، وهي : العمارة ، والعبادة ، والخلافة.[5] يقول : ” ومن لم يصلح لخلافة الله تعالى ، ولا لعبادته ، ولا لعمارة أرضه ، فالبهيمة خير منه”[6]
فهذه هي الشريعة ، وهذه هي مكارمها ومقاصدها ، وهذا هو المفهوم الأول لها.
ومع التوسع العلمي وتشعب التخصصات العلمية ، ظهر استعمال الشريعة استعمالا اصطلاحيا. والاستعمال الاصطلاحي عادة ما يضيق من مدلولات الألفاظ ، ويقصُرُها على بعض مدلولاتها اللغوية.
ومن المعاني الاصطلاحية الخاصة التي استُعمل بها لفظ الشريعة ، المعنى الذي يعنبه الصوفية عندما يقابلون بين “الحقيقة والشريعة”. فالشريعة هنا ، صُرف معناها إلى التكاليف والضوابط الشرعية الظاهرة ، الموجهة إلى”عامة” المكلفين . وأما الحقيقة ، فهي الجواهر والبواطن والأسرار التي يدركها “الخاصة” من العباد والزهاد والعارفين …ومن هنا نشأ القول بعلوم الظاهر وعلوم الباطن ، وتم على هذا الأساس التفريق بين وظيفة الفقه ووظيفة التصوف.وهي كلها اصطلاحات وتقسيمات طارئة ، ينبغي ألا تحجب عنا المعاني والمفاهيم الشرعية، كم هي في نصوص الشرع ، وكما هي عند المتقدمين.
على أن أشهر استعمال اصطلاحي للفظ الشريعة ، هو استعمالها للدلالة ـ بصفة خاصة ـ على الأحكام العملية في الدين، أي كل ما سوى العقائد ، لكن مع الاحتفاظ في هذه الدلالة بجميع المجالات التشريعية العملية الواردة في الدين ، ومنها العبادات الظاهرة والباطنة ، والأخلاق والآداب . فالشريعة بهذا المعنى تشمل الدين كله إلا العقيدة . ومن هنا جاء استعمال عبارة ” الإسلام عقيدة وشريعة.”[7]، على أساس أن العقيدة غير الشريعة.
ومنذ قرون طويلة ، أصبح هذا المعنى هو الأكثر شيوعا واستعمالا لدى العلماء، ولكنه لم يُلغ المعنى الأول والأعم للشريعة والشرع ، كما أنه ظل واسعا وشاملا لكل المجالات التشريعية . فمجال الشريعة هنا أصبح تقريبا هو نفسه مجال “الفقه” ، بمعناه الاصطلاحي المعروف . ويبقى الفرق بينهما هو أن الشريعة تطلق على ما هو منزل ومنصوص وصريح ، من الأحكام ومن القواعد الشرعية ، بينما الفقه ـ أو علم الفقه ـ يراد به خاصة ما هو مستنبط ومجتهَد فيه.
وفي العصر الحديث اتجه استعمال اسم الشريعة نحو مزيد من التخصيص والتقليص، وخاصة حينما بدأ التعبير بلفظ ” التشريع الإسلامي” ، على غرار ” التشريع” بمعناه القانوني . وهكذا بدأ لفظ الشريعة والتشريع الإسلامي ، يطلقان على التشريعات المنظمة للحياة العامة . وهو اصطلاح العلامة ابن عاشور ، الذي يقول:” فمصطلحي[8] إذا أطلقت لفظ التشريع أني أريد به ما هو قانون للأمة، ولا أريد به مطلق الشيء المشروع. فالمندوب والمكروه ليسا بمرادَيْن لي، كما أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن تسمى بالديانة.”[9]
وبهذا أصبح معنى الشريعة مماثلا ـ أو مقابلا ـ لمعنى القانون . ومن هنا جاءت المقابلة والمقارنة بين (الشريعة الإسلامية) و(القوانين الوضعية) . وقد تعززت هذه المقابلة ، وتحولت إلى خصومة ومنافسة ، بسبب ما تعرضت له أحكام الشريعة ـ المدنية والجنائية ـ من إزاحة قسرية ، لفائدة القوانين المستوردة من الغرب. وهذا ما جعل العلامة الأستاذ علال الفاسي يتحدث عن صراع بين ( الشريعة الإسلامية ) و(الشريعة الاستعمارية)، وذلك في كتابه القيم (دفاع عن الشريعة) .
في خضم عملية “التطهير التشريعي” ، التي سهرت عليها ـ وما زالت ـ الدول الاستعمارية ، ارتفعت درجة الحساسية ضد هذا المسار، بل أصبحت هذه الحساسية جزءا من الصحوة الإسلامية ومحركا من محركاتها . وهنا رُفع شعار”تطبيقالشريعة” ، الذي اتجه أساسا إلى الشريعة بأضيق معانيها ، أي الشريعة الممثلة في قوانين الدولة ومحاكمها ، باعتبار أن هذا المعنى هو”محل النزاع وميدان الصراع”.
وبما أن أول وأبرز ضحايا “التطهير التشريعي” ، كان هو المجال الجنائي، فإن رد الفعل قد تركز على هذا المجال وعلى تضخيمه . وهكذا بدأت عملية اختزال لمفهوم الشريعة ولتطبيق الشريعة ، في تطبيق العقوبات الجنائية الإسلامية . وأصبحت “الحدود الشرعية” رمزاً لتطبيق الشريعة أو رمزا لتعطيل الشريعة .
والخلاصة : أن المعاني الخاصة والمضيقة لمفهوم الشريعة ، ينبغي أن توضع وتفهم في سياقها ومجالها ، وينبغي ألا تحجبنا أوتحجب عنا المعنى الأصلي والكامل للشريعة.وعلى هذا الأساس ، يمكننا التحدث عن تطبيق الشريعة .. فلنتابع
شريعة .. بلا حدود
رأينا من قبل أن الشريعة الإسلامية ، هي كل ما أنزله الله وأرسله إلى عباده ، تنفيذا لوعده القديم : )قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى …({سورة طـه:123}
فالقرآن الكريم ، وكل ما تضمنه ، من فاتحته إلى نهايته ، هو الشريعة الإسلامية . والسنة النبوية الصحيحة كلها ، وكل ما فيها ، هي الشريعة الإسلامية.
فالإيمان بالله ، والخوف من الله ، والحياء من الله ، وتقوى الله ، كلها شريعة الله.
وعبادة الله ، والتوكل عليه ، والإخلاص له ، وذكره وشكره ، كلها شريعة الله.
والتخلق بمكارم الأخلاق والآداب ، من عدل وإحسان ، وصدق ووفاء ، ورفق وتواضع … كل هذا من شريعة الله . وكذلك التنزه والتخلص من سفائف الأخلاق ورذائلها.
والتعفف عن الخبائث والمحرمات ، والوقوف عند المباحات الطيبات ، جزء من الشريعة ومن تطبيق الشريعة.
وطلب العلم ـ أي علم نافع ـ وبذله ونشره والمساعدة عليه ، عبادة وشريعة.
وكل ما يحقق ويخدم مقاصد الشريعة ، في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، فهو من صميم الشريعة، ومن مصالح الشريعة ، كما قال الإمام الغزالي : “ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة.”[10]
والزواج وحسن العشرة الزوجية شريعة ، وإنجاب الأولاد وتربيتهم وتعليمهم ، شريعة.
وكل ما يجلب أو يحقق أو يعزز كرامة الإنسان ورفعته ، المادية أو المعنوية ، فهو من الشريعة ومن إقامة الشريعة.
وكل عمل أو مجهود يرفع عن الناس الظلم والقهر والتسلط والاستبداد ، فهو من صميم الشريعة .
والحكم بين الناس بما أنزل الله ، وبكل ما هو عدل وإحقاق للحق ، هوجزء كبير من شريعة الله ،كما قال العلامة ابن القيم : “فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ، ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق ، وقامت أدلة العقل ، وأسفر صُبحه بأي طريق كان ، فثم شرع الله ودينه ورضاه.”[11]
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ركن من أركان الشريعة . ومثله التعاون على البر والتقوى.
وكل إصلاح ونفع على وجه الأرض ، وكذلك كل إزالة أو إعاقة ، لأي فساد أو ضرر في الأرض ، فهو من الشريعة.
وإسداء النفع والإحسان إلى الحيوان ، هو تطبيق للشريعة ، كما جاء في الحديث النبوي الشريف :”بينما رجل يمشي بطريق ، اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فنزل فيها ، فشرب ، ثم خرج ، فإذا كلب يلهث ، يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلبَ من العطش مثلُ الذي بلغ بي ، فنزل البئرَ ، فملأ خفه ماءً ، ثم أمسكه بفيه حتى رَقيَ ، فسقَى الكلب ، فشكر الله له ، فغفر له . فقالوا : يا رسول الله ، إن لنا في البهائم لأجراً ؟! ، فقال صلى الله عليه وسلم : « في كل ذات كبد رطبة أجر »[12]
ومن هذا المعين الشريف استقى الإمام عز الدين بن عبد السلام ـ وهو يعدد صنوف الإحسان التي جاءت بها الشريعة ـ قوله:” الإحسان إلى الدواب المملوكة ؛ وذلك بالقيام بعلفها ، أو رعيها بقدر ما تحتاج إليه ، وبالرفق في تحميلها ومسيرها ، فلا يكلفها من ذلك ما لا تقدر عليه ، وبأن لا يـحلُب من ألبانها إلا ما فضل عن أولادها ، وأن يهنأ جرباها ، ويداوي مرضاها ، وإن ذبحها : بأن يحد شفرته ويسرع جرته ، مع إضجاعها برفق ، وأن لا يتعرض لها بعد ذبحها حتى تبرد . وإن كان بعضها يؤذي بعضا بنطح أو غيره ، فليفرق بينها وبين ما يؤذيها، فـ(في كل كبد رطبة أجر)…وإن رأى مَن حمل الدابة أكثر مما تطيق، فليأمره بالتخفيف عنها ، فإن أبى فليطرحه بيده ، فـ(مَن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان) . وقال عليه السلام 🙁 إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض ، وإذا سافرتم في السنة[13]، فبادروا بها نـقيها[14]) ، وقد غُفر لبغي بسقي كلب”[15]
ولو ذهبنا نستعرض تشعبات الشريعة وامتداداتها ، لما بقي شيئ أو فعل، إلا وجدنا له مكانه فيها . فهي شريعة الإنسان ظاهرا وباطنا ، فردا وجماعة . وهي شريعة الدنيا والآخرة ، وشريعة الدولة والمجتمع.
ومن أجمع التعبيرات عن معنى الشريعة وطبيعتها ومضامينها ، حديثْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – : “الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ – أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ – شُعْبَةً ؛ أَعْلَاهَا: قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَان ِ”[16].
ولا شك أن هذه الشعَب ـ أو الأبواب كما بعض روايات الحديث ـ تغطي الدين كله ، والشريعة كلها. ولكن الحديث لم يعين منها إلا أولَـها وآخرها ، وثالثةً بينهما.
غير أن الشعب الثلاث التي سماهما الحديث ـ وهي: لا إلـه إلا الله ، وإماطة الأذى عن الطريق، والحياء ـ تنبئ عما سواها ، وعما بينها.
فشهادة (لا إلـه إلا الله) ، هي رأس الإيمان والإسلام ، وهي رأس هذه الشعب . فمنها تتفرع وتنحدر بقية الشعب ، حتى نصل إلى إماطة الأذى عن الطريق. وبين الأولى والأخيرة تقع شعبة الحياء.
ومعنى هذا أننا أمام تصنيف إجمالي ثلاثي للشريعة:
- صنف العقائد والأسس ، وبدايته ورأسه : ( لا إلـه إلا الله ).
- صنف الأخلاق ، ومثاله ونموذجه ، الخلق الفطري الرقيق : الحياء.
- صنف المعاملات والتكاليف العملية ، ومثاله بأدنى درجاته : إماطة الأذى عن الطريق.
وداخل هذه الأصناف الثلاثة ، تتوزع وتترتب سائر توابع الإيمان ومضامين الشريعة . وقد اجتهد العلماء وتفننوا في البحث عن هذه الشعب البضع والسبعين ( أو البضع والستين ) ، وتصنيفها وترتيبها. وألف بعضهم كتبا خاصة في بيان ( شعب الإيمان ) ، منهم الفقيهان الشافعيان الكبيران : أبو عبد الله الحليمي ( المتوفى سنة403) وأبو بكر البيهقي ( المتوفى سنة458). ومنهم العلامة المالكي عبد الجليل القصري( القرطبي) ، دفين مدينة القصر الكبير بالمغرب ( توفي سنة 608).
وإنما ذكرت هؤلاء العلماء ومصنفاتهم في هذا الموضوع ، لأن هذه المصنفات هي خير ما يعكس لنا مضمون الشريعة الإسلامية ، كما هي ، وانطلاقا من حديث نبوي لا شك في صحته.وإن أي نظرة على فهارس هذه المصنفات ، لَتكشفُ لنا عن المعنى الشمولي ، الجامع المتوازن ، للشريعة: بعقائدها، وعباداتها ، ومعاملاتها ، وأخلاقها ، ورقائقها ، وآدابها ، ومحرماتها ، وعقوباتها …
فكل من عمل بشيئ من هذا كله ، فهو عامل بالشريعة ، وقائم بتطبيق الشريعة ، سواء كان فردا ، أو كان جماعة ، أو دولة أو حكومة ، أو رئيسا أو مرؤوسا ، أو أمة أو مجتمعا. وأيٌ من هؤلاء خالف وخرق شيئا مما ذكر من الشريعة ، فهو يعطل من الشريعة بقدر مخالفته وخرقه.
فالكذب تعطيل للشريعة ، مثلما أن الصدق تطبيق لها.
والغش في الدراسة أو التدريس ، أو الصناعة أو التجارة ، أو في الخدمات أو في الانتخابات ، تعطيل للشريعة ، مثلما أن إتقان العمل ، وإكماله بنزاهة وإخلاص، هو تطبيق للشريعة.
وإخلاف الوعود تعطيل للشريعة ، والوفاء بها عمل بالشريعة.
وهكذا حتى نمر على كل شُعَب الشريعة وكل مضامينها …
إن من يدرك هذا المعنى الحقيقي للشريعة ، لا يمكنه أن يقول اليوم : إن الشريعة معطلة، أو إن تعطيل الشريعة ، أو تطبيق الشريعة ، هو بيد الدولة ومن اختصاص الدولة ، أويحتاج إلى قيام “الدولة الإسلامية” ، أو قيام الخلافة…كما لا يمكنه السقوط في حصر الشريعة ، في عدد محدود من أحكامها ، أو من نظامها العقابي بوجه أخص.
إن مقولات : “تعطيل الشريعة ، وإلغاء الشريعة ، والمطالبة بتطبيق الشريعة” ، كلها تصبح نسبية الصحة ، بل قليلة الصحة..
فتعطيل أحكام من الشريعة صحيح ، لكن ما نسبتها من مساحة الشريعة؟ ما عدد الشعَب المعطلة من مجمل شُعَب الشريعة؟ وما نسبة التعطيل في كل شعبة؟ وهل التعطيل خاص بالحكام والمحاكم؟
وأيضا لا يمكن ـ بعد تصحيح مفهوم الشريعة ـ القول : بأن الشريعة لم تطبق ـ عبر التاريخ ـ إلا لفترة محدودة ، هي الفترة النبوية وفترة الخلفاء الراشدين . لقد ظل المجتمع يعمل ويعيش بالشريعة . وظل القضاة والمحتسبون يطبقون الشريعة . وظل العلماء يفتون الناس بالشريعة. وظلت ثقافة الناس وأفكارهم وقيمهم ، تتغذى بالشريعة ، وتتنفس الشريعة.
هذه الأيام سمعت محللا “إسلامولوجيا” مغربيا ، يتحدث بحسرة وأسف ، عما سماه “عملية الأسلمة” الجارية في المجتمع المغربي! وبغض النظر عن هذا الاستلاب والاغتراب الأليم ، فإني أستنتج من هذه الشهادة أن منسوب الشريعة في المجتمع آخذ في الارتفاع والتحسن ، بدون دولة ولا حكومة ولا خلافة !
ومثل هذا الاستنتاج خطر لي ، وأنا أسمع ـ هذه الأيام أيضا ـ أخبارا عن مظاهرات غريبة ، يراد تنظيمها – ونظم بعضها – ببعض الدول الأوروبية ، ضد ” أَسْلَمة أوروبا” !!، مع أننا ـ نحن العرب والمسلمين ـ لم نتظاهر يوما ، ضد فرْنَـسة المغرب العربي ، ولا ضد تغريب العالم الإسلامي أو عَلْمَـنَـته ، ولم نتظاهر ضد الأَوْرَبة ولا ضد الأمركة ولا ضد التلتين [17]…
تطبيق الشريعة بين الدولة والمجتمع
لقد اتضح من خلال الحلقتين الماضيتين ، مدى اتساع الشريعة وامتدادها وتنوع مضامينها ، وأنها ليست بذلك الضيق الذي يتصوره أولئك الذين يرهنون الشريعة بيد القضاة والولاة ، أو بيد المحاكم والحكومات ، فإن هم طبقوها فقد طُبقت وعاشت ، وإن هم نبذوها ، فقد عطلت وماتت!
فالشريعة أكبر شأنا من أي يكون مصيرها ، وتطبيقها وتعطيلها ، بيد حفنة من الحكام والولاة ، وتحت رحمتهم وتقلباتهم.
نعم للشريعة أحكام جنائية ومدنية ، ولكن هذه الأحكام جزء من الشريعة ، وليست كل الشريعة ، وليست رمزا للشريعة.
نعم أيضا ، فإن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن[18]، ولكن هذا من قبيل قولهم : يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ويوجد في البئر ما لا يوجد في النهر.
فمعنى أن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن : أن هناك حالات وأصنافا من الناس يجدي معهم السلطان ، أكثر مما يجدي معهم القرآن ، ويخضعون للسلطان أكثر مما يخضعون للقرآن ، كما هو حال بعض العتاة والمنافقين والمتهورين . ولذلك قال العلامة الشنقيطي في تفسيره :”فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب ، والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.”[19]
ولكن وازع الضمير والتقوى والإيمان ، يبقى دائما قبل وازع السلطان ، ويبقى هو الأصل وهو المعول عليه في الدين ؛ إذْ وازع السلطان إنما يحكم بعض الظواهر ، أما وازع الإيمان فيحكم الظواهر والسرائر. وفي الحديث الصحيح : ” إِن الله لا ينظر إِلى أجسادكم ، ولا إِلى صُوَرِكم ، ولكن ينظر إِلى قلوبكم وأَعمالكم” . فالدين الحق ، والتطبيق الحق للدين وشريعته ، إنما هو أساسا ما جاء عن إقناع وترغيب ، وطواعية ورضى . وما سوى ذلك ، فهي ضرورات تقدر بقدرها ، وآخر الدواء الكي.
على أن ما يَـزَعُه الله تعالى بواسطة السلطان لا يعني دائما القوة والعقوبة .بل السلطان نفسه ، يجب أن يدفع وينفع بالتي هي أحسن ، قبل أن يفعل ذلك بالتي هي أخشن . فالسلطان إذا كانت له مشروعيته ومصداقيته ، هو نفسه تكون له كلمته المسموعة والمطاعة ، من غير قوة ولا بطش . وفي متناوله من الأساليب التعليمية والتربوية والتوجيهية الشيئ الكثير ، مما يمكنه من أن يخدم الشريعة ويحقق الكثير من أحكامها ومقاصدها ، دون قوانين ولا محاكم ،ودون سلطة ولا شرطة.
وأياً ما كانت أهمية السلطة والدولة في إقامة الدين وتطبيق الشريعة ، فإنها تبقى ـ ويجب أن تبقى ـ دون أهمية الأمة والمجتمع.وذلك لعدة أسباب.
- أولا ، لأن الدين الذي يطبق بدون ضغط ولا إكراه ، هو الدين الحقيقي المقبول عند الله تعالى . وأما ما سواه ، فإنما هو تنظيم دنيوي وتدبير سلطوي.
- وثانيا ، لأن ما يطبق برغبة وطواعية ، يكون أجود وأدوم ، بخلاف التطبيق بالقوة والسلطة ، فإنه يكون رديئا سطحيا ، ينحسر وينقلب عند كل فرصة لذلك .
- وثالثا ، لأن التطبيق الذي يكون بمبادرة ذاتية من الأفراد ، أو بحركية المجتمع نفسه ، يعطي من السمو والارتقاء في وعي المجتمع وفاعليته ، ما لا سبيل إليه بدونه.
وإذا كانت هناك مجالات وأحكام شرعية ، لا بد فيها من الحكام ومؤسساتهم ووسائلهم ، كالقضاء وما يصدر عنه من إكراهات وعقوبات ، فإن للأفراد وللمجتمع إمكانات واسعة للتدخل والإسهام ، حتى في هذه المجالات أيضا .
فإذا كانت إقامة الحدود وغيرها من العقوبات الشرعية ، جزءاً مهما من تطبيق الشريعة تختص به الدولة ، فلا شك أن كل عمل دعوي أو تربوي أو اقتصادي أو اجتماعي ، يحول دون وقوع الجريمة ومعاقبة المجرمين ، هو أيضا من الشريعة ومن تطبيق الشريعة ، بل هو أفضل أشكال تطبيق الشريعة . وهو ما يستطيعه كل الأفراد والهيئات المجتمعية .
ومن أراد أن يتأكد من مساحة الدولة ومساحة الأمة ، في تطبيق الشريعة ، فليقرأ القرآن من أوله إلى آخره ، ولْـيُسجل في مكانين منفصلين :
ـ ما يتوقف على الدولة ولا يتم إلا بها ،
ـ ما لا يتوقف على الدولة ويمكن أن يتم بدونها،
ثم ليحسب ولينظر النتيجة …
لقد عرف العالم الإسلامي ، عبر تاريخه الطويل ، دولا وحكومات مختلفة في قوتها وضعفها ، واستقامتها وانحرافاتها ، وقربها وبعدها من هدي الشريعة ومقتضياتها، ولم يكن ذلك هو العنصر الحاسم في تطبيق الشريعة ودوامها، أو في رقي الأمة وازدهارها.ولذلك نجد فترات زاهية بالرقي العلمي والحضاري والاجتماعي ، هي في الوقت نفسه فترات ضعف وتفكك في النظام السياسي القائم.
فبجانب الحكام وأجهزتهم وأدوارهم ، كان للقضاء والقضاة دورهم وفاعليتهم . وكذلك كان للعلماء عطاؤهم واجتهادهم وزعامتهم ، وكان للخطباء والوعاظ أدوارهم التعليمية والاجتماعية …
وكان للطرق الصوفية أدوارها التربوية والاجتماعية ، وأحيانا الجهادية .
وكان المجتمع بكل فئاته ، ملتفا متفاعلا مع هؤلاء جميعا ، يأخذ منهم ويعطيهم ، ينخرط معهم في توجيهاتهم ومشاريعهم ونداءاتهم ، وينخرطون معه في مشاكله ومتطلباته وشكاويه.
وكل هؤلاء كان مصدرهم وملهمهم ، هو الشريعة والعمل بالشريعة.
ولست متغافلا عن السلبيات والانحرافات التي عرفها تاريخنا في مختلف عهوده ، ولكن السياق ـ الآن ـ يقتضيني بيان كيف أن الشريعة لم تكن في يوم من الأيام قضية دولة أو حكومة أو سلطة ، بل كانت دوما قضيةَ أفراد ومجتمع وأمة ، ودولة أيضا .
لقد كان “المجتمع المدني” ـ بتعبير اليوم ـ حياً فاعلا قائما بذاته ، وخصوصا عند تقصير الحكام ، أوعند ضعف قيامهم بواجباتهم.
لقد كان “المجتمع المدني” هو المصدر الأول والـمُـنَـفذ الأول والممول الأول ، للمشاريع والمؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها.
وهكذا يقال في مجال الخدمات والمرافق الاجتماعية، والبنيات والتجهيزات التحتية.
وكانت مبادرات بعض الحكام والأمراء ، غالبا ما تأتي ـ إذا أتت ـ لمجاراة المجتمع والانخراط في حركيته ، أو للعمل على الإمساك بها والتحكم فيها.
ومما لا يحتاج إلى إثبات أو بيان : الدور الريادي الكبير للأوقاف ، في كل هذه الحركية والفاعلية ، المجتمعية والسلطانية معا.
ويتشرف المغرب بتجارب حضارية باهرة في هذا المجال ، من أبرزها وأشهرها أعجوبة (القرويين)، التي بدأت مسجدا محدودا في مكان محدود ، قامت ببنائه شابة مؤمنة من عموم الناس، ثم انتهت (جامعة) عالمية كبرى ، أشعتْ منارتها شمالا وجنوبا وشرقا ، على مدى عدة قرون ، إلى أن جاء الاحتلال الفرنسي ، ليطمس نورها وينتقم منها.
هذه (القرويين) ، التي وُلدت في فاس ، تحولت ـ على مر القرون ـ إلى شبكة واسعة من الفروع والمدارس ، تنتشر في سائر مدن المغرب وقراه ، تُسابقها شبكةٌ أوسع من الأحباس المخصصة لخدمتها وتنميتها والإنفاق على جميع احتياجاتها . لقد كنا نسمع ـ إلى عهد قريب ـ أن ( القرويين ) هي أغنى أغنياء المغرب ؟!
ومنذ ظهور (القرويين) في القرن الثالث الهجري ، أصبح من الصعب أن نجد في تاريخ المغرب عالما أو فقيها أو أديبا أو مؤرخا أو فلكيا أو طبيبا أو ملكا أو سياسيا …، دون أن يكون قد درس في القرويين أو في أحد فروعها .
وإذا كان المصريون يفتخرون بنهر النيل العظيم ، ويقولون ” مصر هبة النيل”، فإن على المغاربة ألا يكفوا عن الافتخار بالقرويين ، وأن يعتبروا ” المغرب هبة القرويين”. ومن أواخر ما وهبته القرويين للمغرب ، هو استقلال المغرب ، الذي انطلقت حركته ، وخرج زعماؤه وأبطاله، منها ومن شبكتها. فكم رد المغرب المستقل وكم وفى؟!
إن جامعة القرويين ، هي علامة بارزة على أهمية العمل الأهلي ، ودوره الكبير في خدمة الشريعة ، وفي تطبيق الشريعة ، ليس في فقط في دُور القضاء ، بل في كل في كل بيت وحي وقرية وفضاء.
ومن الأمثلة المعاصرة على دور المجتمعات وعملها الأهلي ، في تطبيق الشريعة ، تجربة البنوك الإسلامية . فإلى منتصف السبعينيات من القرن الماضي ، لم يكن في عالم البنوك والمعاملات البنكية ، إلا النمط الربوي الغربي . وفي سنة 1975، بدأت التجربة المصرفية الإسلامية من الصفر، وانطلقت وسط تعقيدات قانونية بالغة ، ووسط تحديات التفوق الكاسح للبنوك الربوية المحتكرة للسوق . ومع ذلك ، فإن عدد المؤسسات البنكية الإسلامية ، قد بلغ عام 2006 نحو 300 مصرف ومؤسسة ، موزعة على 60 دولة.وقد بلغ رأسمال هذه الفئة من البنوك نحو 13 مليار دولار، وتتراوح أصولها بين 700 و900 مليار دولار[20]. ويصل نـمو البنوك الإسلامية بنسبة 23 % تقريبا ،بينما تنمو البنوك التقليدية بنسبة 10% تقريبا.[21]
المهم عندي في هذه التجربة ، هو أنها تجربة أهلية بالدرجة الأولى، تضافر فيها ضغط العلماء والدعاة والمفكرين ، مع التجاوب الشعبي ، المتمثل في الامتناع العريض عن الانخراط في المعاملات البنكية الربوية. ثم جاءت المبادرة العملية من بعض المستثمرين الرواد …وقد تلقت معظم الحكومات في العالم الإسلامي ، وفي العالم العربي بصفة خاصة ، هذه التجربة بالمنع ، أوالتحفظ ، أو التخوف والمعاكسة. ولكن هذه المواقف الآن آخذة في التفهم والتقبل والتسليم ، تحت ضغط الواقع ونجاح التجربة.
ومن التجارب الأهلية ، أو الأهلية الحكومية ، في تطبيق الشريعة في هذا العصر: تجربة الوقف ، وتجربة الزكاة . والوقف الإسلامي هو نفسه جزء من الشريعة ، وأما الزكاة فركن من أركانها . ولكن الأهم هو أن جميع ما ينجم عنهما وعن ثرواتهما، من خدمات ومصالح ومشاريع ، إنما هو من أحكام الشريعة ومن تطبيقاتها.وهناك تجارب معاصرة ممتازة لهما ، في كثير من الأقطار الإسلامية ، وحتى في بعض الدول الغربية .
ما لا ينتهي منه العجب ، هو لماذا بعض الحكام والحكومات ، ما زالوا يرفضون الاستفادة لدولهم وشعوبهم ، من هذه الفرص العظيمة التي لن تكلفهم شيئا؟!
إن الوقف[22] والزكاة ، سيعززان ويُـمدان الخدمات والمرافق الاجتماعية والتعليمية ، بأموال ضخمة متجددة ، تتدفق من إيمان الناس وتجاوبهم مع دينهم وشريعتهم ، قبل أن تتدفق من جيوبهم . وتستطيع أموال الوقف والزكاة ، أن تمول ما لا يحصى من المدارس والجامعات ، ومِنَح الطلبة ، ومشاريع البحث العلمي ، ومن تشييد الأحياء السكنية الجامعية ، وتجهيز المكتبات ، وتشغيل الخريجين …
[1]تفسير الطبري 21 / 512
[2]تفسير الطبري , 10 / 384
[3]الجامع لأحكام القرآن 8/83
[4]الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 83
[5]نفسه ص 82 ـ 83
[6] ص83
[7]وهو عنوان كتاب للشيخ محمود شلتوت ، شيخ الأزهر الأسبق
[8]فهو ينبه على أن هذا اصطلاح خاص ، يستعمله في هذ الكتاب ( أي : مقاصد الشريعة الإسلامية )
[9]مقاصد الشريعة الإسلامية ص 129
[10]المستصفى1 / 438
[11]أعلام الموقعين4/ 373
[12] صحيح ابن حبان 3/81
[13]أي في وقت الجدب
[14]النقي ـ بكسر النون ـ الشحم ، والمقصود هنا الإسراع بالوصول أو العودة ، لكي تأكل الإبل وتشرب ، قبل أن تستهلك طاقتها المدخرة
[15]شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ، ص 163
[16]متفق عليه
[17]مصطلح” التلتين” ، يستعمله الدكتور أحمد العماري ، ويريد به فرض الثقافة اللاتينية ودمج الناس فيها …
[18]يَـزَعُ بمعنى يمنع ويكف عن السوء ، وهذه الحكمة مروية عن عمر ، وعن عثمان ، رضي الله عنهما ، وليست حديثا كما يُظن
[19]أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 1 / 484
[20] الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي http://isegs.com/forum/archive/index.phpt-442.html
[21]حسب تقرير أعده المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين
[22] أعني الوقف الاجتماعي وليس الوقف المخصص للمساجد